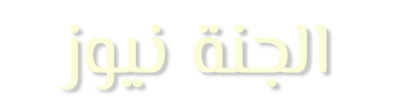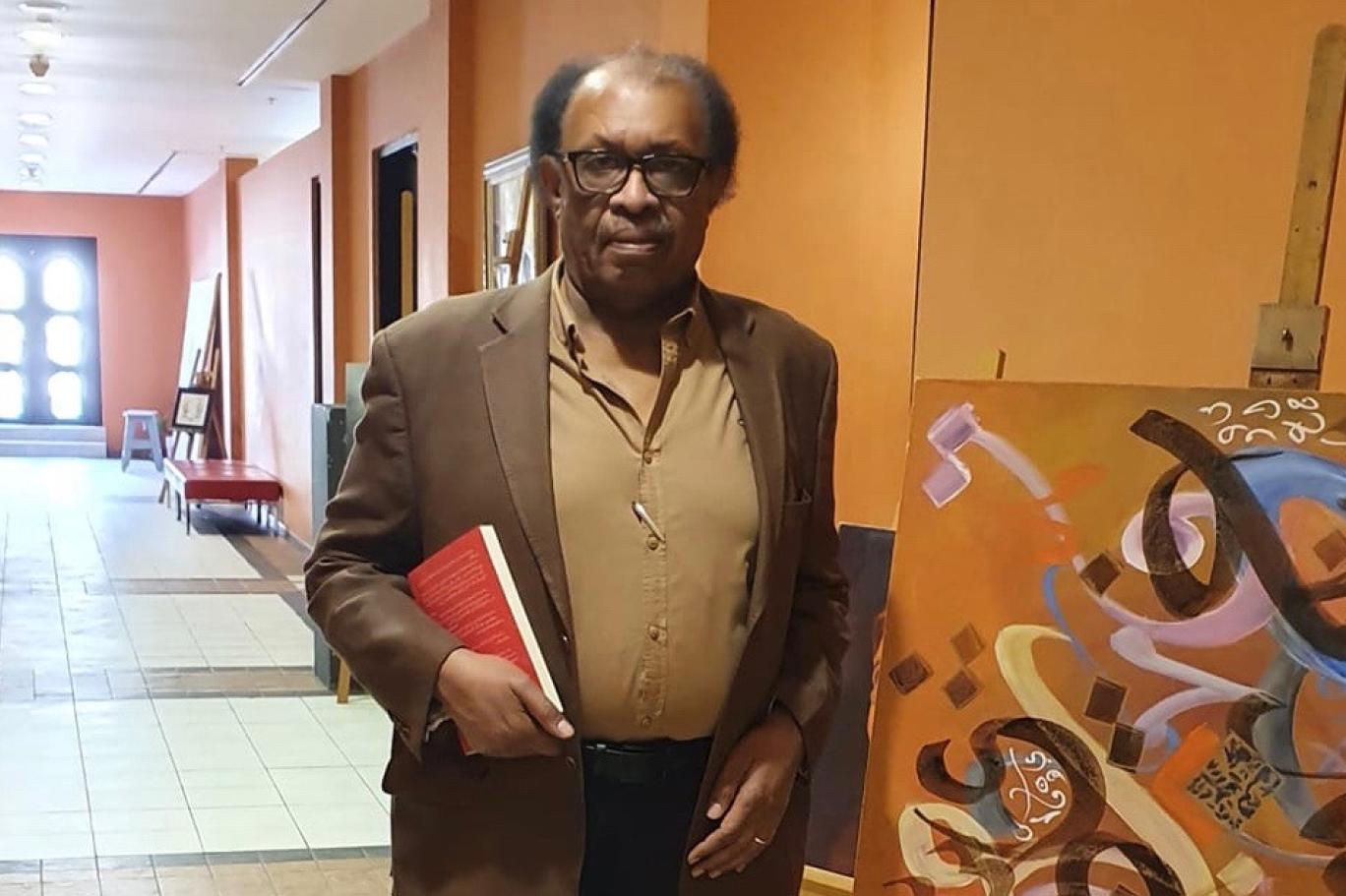تدور رواية “عورة في الجوار” حول زمن الثمانينيات من القرن الـ20، حين دخل السودان عصر الأفكار المثالية، بالتزامن مع هجمة المظاهر المدينية إلى الريف، وتداخلها مع المعتقدات المحلية، من دون أن تتلاشى مؤثرات الزمن الماضي البعيد (ملوك الجعليين) إبان حكم الخديويين، في القرن الـ19، على حياة أهل الريف السوداني.
الحبكة الأبس
في الرواية هذه، يحتاج المطلع على مضامين العمل إلى إتمام قراءتها، ومعاودة ذلك، حتى يدرك أن حبكتها بسيطة، بل أبسط مما كان يظن، ومفادها بأن شخصاً يدعى سعيد الورّاق، صاحب شاحنة لوري، تنقل البضائع بين الريف والعاصمة، في الـ20 من عمره، أحب امرأة جميلة تدعى “الرمانة العوض”، على رغم أنها متزوجة برجل يدعى “هارون مسلّم” مهرج البلدة ذات الخمسة آلاف نسمة. ولما يزداد إصرار العاشق، صاحب لقب “كلب الحر”، ويصاب بمس من الجنون، يأتي بشاحنته فيوقفها أمام منزلها، غير آبه بما ستؤول إليه حاله. وللمفاجأة وغرابة المصائر، المتخيلة بالطبع، أصدرت السلطة لائحة “الشوارع” في 14 بنداً، وفي الثالث منها “يسمح للعشق بكل حالاته، ابتداء من النظرة وحتى الموعد واللقاء، ويسمح بإلقاء العبارات الغزلية نثراً وشعراً” (ص 107).
وكأن المقصود بتلك اللائحة تمكين سياسة الإلهاء والتخدير في التعامل مع عامة الناس، فينصرفون إلى مشاغلهم الصغيرة، وينسون المظالم التي باتت السلطات المعسكرة تعرضهم لها. وتنتهي الحكاية، المشتتة العناصر، بإصابة “كلب الحر” (سعيد الورّاق) بمرض الأرتيكاريا أو الحساسية الجلدية، جعله ينسى عشقه، ويهمل كل رسائله الغرامية إلى معشوقته عبر الإذاعة. ومقابل ذلك، تروح تنتشر لائحة “الغضب” المضادة يدعو فيها الموقعون رئيس البلاد إلى تخليصهم من لائحة الشوارع ومن كلب الحر ومن تيس سليمان والمهراجا وسعيد الورّاق…
التهكم والفكاهة السوداء
لو عددنا الأساليب والنبرات السائدة في رواية “عورة في الجوار”، لقلنا إن ثمة نبرة أو مناخاً من التهكم الحامل دلالات غالبة في روايات الديستوبيا، عنيت بها تسليط الضوء على ارتكابات السلطة الميالة إلى عسكرة النظام وتوزيع مغانمها على الجنرالات، في موازاة توزيع الألقاب على المنتفعين من عامة الناس وتوليف تيارات مدنية، منسجمة مع السلطات العسكرية وما يتبعها من ميليشيات مسلحة، لدى كل انقلاب، أو انفصال جزء من البلاد وإعلان استقلاله دولة ناجزة (جنوب السودان). لا يكاد يغيب ظل الهزء من خطاب الحاكم العسكري، ولا التهكم من الفصول الثمانية التي تتألف منها الرواية، باعتبار أن ظاهرة “كلب الحر” والمعتبر بسلوكه الغرامي الفاقع والخالي من الرجولة، “عورة” (“كل أمر يستحيا منه”، محيط المحيط، ص 643) إنما هي نتاج طبيعي لمنهج الإخضاع الذي لا تني تمارسه السلطة الحاكمة، وتجرد عبره الناس من أي حق وكرامة، سوى حق التخريف والقص والشكاية بعضهم على بعض، ومواصلتهم أفعالهم الخارقة للأصول والأعراف والتقاليد الرشيدة.
“فجأة دخل المساعدون مهمومين، رفعوا تحايا عسكرية أشد إرهاقاً من تلك التي رفعوها بشأن حروب الجنوب، وقضايا النهب المسلح في الغرب، وسطوة الميليشيات الهمجية على الأمن والأمان في طول البلاد وعرضها. صبوا الغضب الموقع من الرمانة، وزوجها هارون، والآخرين على فنجان قهوته مقروناً بنسخة مهترئة من لائحة الشوارع ذات الأربعة عشر بنداً…” (ص 9).
ولكن هذا النهج التهكمي والمطعم بقدر من المبالغة الهازئة بالحكم العسكري المسيطر على أحوال هذا المجتمع الريفي الذي منه “العورة”، شخصية الرواية الرئيسة، ولئن تمثل فيه الكاتب أمير تاج السر بالنهج الغرائبي المنسوب إلى ماركيز ومدرسته، لا سيما في روايته الشهيرة “مئة عام من العزلة”، فإنه يبقى أبعد من النموذج المحتذى لدواعٍ عدة، أهمها موسوعيته الواقعية المحدودة، قياساً إلى الموسوعية الفياضة لدى الأول، ولأمر آخر، وهو المهم برأينا، أن هذه الغرائبية المفترضة لدى الكاتب تاج السر لا تعدو كونها قلباً لوجهة الأحداث الواقعية وتبديلاً لسير العلاقات والصراعات والرغبات، وليس ابتكاراً محضاً لعالم غريب حقا|ً عن العالم المرجعي الذي تحتكم إليه شخصيات الرواية.
بين السرد والخطاب
يدرك الكاتب تاج السر، صاحب المسيرة الروائية المديدة، أن أحد شروط اندراج كتابته في سلك الحداثة استيعابه بعض الأساليب المستجدة في الكتابة السردية، من مثل شرذمة بنية الحكاية أو ما يدعى بـ”الحبكة”، ونقل الوضع الأولي إلى الحل، والعقدة إلى الأول، والعكس بالعكس، هكذا دواليك. وهذا ما حصل في رواية “عورة في الجوار”، إذ نعاين بوادر الحل، متمثلاً في “تسلم الرئيس الغضب الموقع من الرمانة وزوجها والآخرين” (ص 8)، لتخليصهم من سطوة “كلب الحر” ونزقه وإصراره على التغزل بالمرأة المتزوجة، ومن يرتبط به، من الذين شجعت السلطات بروزهم واستفحال سيطرتهم على المزاج العام، بغية إلهائهم عن السياسة المعسكرة ونهبهم الخير العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن ثمة شرطاً ضمنياً آخر يلازم الشرط الأول، على ما يدركه الكاتب، وهو حفظ خط السرد واضحاً، ومن دون تشويش يحول دون متابعة القارئ أحداث الرواية، والإلمام ببنية الحبكة. وفي حال ضعف خيط السرد، أو التبس على القارئ، برز الخطاب (الأنثروبولوجي والسياسي والاجتماعي والطبي والنفسي…) على هيئته الخام، ومن غير حامله الذي لطالما كان الراوي العليم، في روايات الكاتب. وفي هذا الشأن، نحسب أن الكاتب قصد في هذه الرواية أن يظهّر جراحاً في المجتمع السوداني الريفي في ثمانينيات القرن الـ20 كانت لا تزال تمعن نزفاً وإيلاماً عند كثيرين، لا سيما الحكام المستبدون الساقطون بمظلات الانقلاب، وبأثواب المخلصين اللاعنفيين (البشير/غاندي)، بالتلازم مع سيادة الفكر الغيبي والسحري عند العامة واضطراب الحبل الاجتماعي وتفكك القيم والفضائل وحلول المثل العليا مكانها، المنسوجة من عباءة الاشتراكية وغيرها. على أن إبرازها، كما تبين لنا، جرى على حساب السرد وخيطه وتظليل ملامح الشخصيات، على رغم سماتها المرسومة بأوصاف دالّة على جوهرها.
اللغة الشعرية
ولا يغيب عن بالنا أن في الرواية (عورة في الجوار) حضوراً لافتاً للشعر العامي السوداني، انسجاماً مع الطابع المحلي الذي يسعى الكاتب تاج السر إلى وسم روايته به، إذ لا يكتمل رسم القصة الغرامية، في الظاهر أقله، من دون الشعر، والغزل بصورة خاصة. وقد وقّع لنا الشاعر في الصفحات (41-42، 89 118) قصائد غزلية مغناة ومتداولة شفوياً بين عامة الناس السودانيين، من مثل: “بنات آخر الزمن ليهن حكاية طويلة/ واسعات العيون والابتسام والحيلة/ كان ضحكن يمدّن ضحكتهن ترتيلة/ وكان قصدن يميتن عاشقهن في ليلة…” ، (ص 41) او :”بللم..بللم../ آل الورّاق ..ليلهم حرّاق./ ضاربين التيه..سمرا ورفاق/ فيهم جعفر، وسعيد وإسحق./ فيهم ورعا..فيهم أخلاق..” (ص 118).
ولئن كانت هذه القصائد المبثوثة في مفاصل من الرواية مختلفة إثباتاً لانغراس الحبكة في بيئتها السودانية، وتبيينا لاندراج الحبكة في إطارها ومعالجتها موضوعاً له صلة بالغزل، فإن إصرار الكاتب تاج السر على تحويل جملته السردية إلى حزمات من صور بلاغية (كنايات واستعارات ورموز) متعاقبة، أثقل القص، ولم يحوله إلى شعرٍ في آن. وعلى أي حال، لم يكُن هذا التحويل ضرورياً أو لازماً ما دام السرد والوصف الواقعيان كفيلين بنقل تجربة الشخصيات وصورها على خير وجه. وكان ممكناً أن يفرد الكاتب، في هامش الصفحات، تفسيراً قاموسياً لبعض العبارات الخاصة بالبيئة السودانية، باعتبار أن القارئ العربي المشرقي، شأننا، لا يلمّ بها.
نقلاً عن : اندبندنت عربية