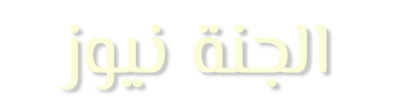يشكل النظام القانوني العراقي منظومة متكاملة لحماية حقوق الطفل، مدعوماً بتشريعات تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفولة، وعلى رغم وجود قوانين راسخة يواجه الواقع العملي تحديات كبيرة تحول دون تحقيق هذه الأهداف.
فحماية الأطفال لا تتحقق بسن القوانين فحسب، بل بتطبيقها بفاعلية على أرض الواقع، لذا يتطلب الأمر نهجاً شاملاً يشمل تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتوفير بيئة قانونية تضمن التنفيذ الصارم لهذه القوانين، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول مسؤولية حماية الأطفال، باعتبارهم ثروة المستقبل وأساس بناء مجتمع متماسك.
الإطار التشريعي
عن هذا الموضوع تحدث القاضي سالم روضان فقال “يتضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أحكاماً صارمة لمعاقبة من يعرض الأطفال للخطر أو يستغلهم في التسول، كما يفرض محاسبة الأولياء الذين يستبيحون أموال القاصرين من خلال أحكام واضحة تعزز الحماية القانونية للأطفال، ويبرز قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل كإطار لحماية القاصرين عبر متابعة أوضاعهم من خلال دائرة رعاية القاصرين، ويمنح المدير العام صلاحية تحريك الشكاوى ضد المكلفين رعايتهم في حال تعرضهم للإساءة”.
وتابع أن “قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة1983 المعدل يوفر تدابير لحماية الأطفال الجانحين من الانحراف، ويلزم أولياء الأمور حسن تربيتهم تحت طائلة العقوبة. ويأتي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لينظم العلاقة بين الوالدين والأطفال في مجالات الرعاية والإنفاق، بينما يعزز قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 272 لعام 1982 دور هيئة رعاية الطفولة في حماية الأطفال وتنميتهم”.
وعلى رغم وجود هذه النصوص القانونية، فإن الانتهاكات بحق الأطفال لا تزال مستمرة، إذ تنتشر ظواهر التسول واستغلال الأطفال في أعمال شاقة إلى جانب تصاعد حالات التشرد، ويعود ذلك لضعف آليات تنفيذ القوانين وتراجع دور المجتمع في حماية الطفولة وسط التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها العراق بسبب الحروب والفساد المستشري.
ويواصل القاضي روضان أن “العراق يُعدّ طرفاً في الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وأبرزها ’اتفاقية حقوق الطفل‘ الصادرة عن الأمم المتحدة عام1989 التي صادقت عليها بغداد بموجب القانون رقم 3 لعام1994 ، مما يجعلها جزءاً من المنظومة التشريعية الوطنية، لكن التطبيق العملي لا يزال يعامل هذه الاتفاقية كتشريع دخيل مما يعكس خللاً في إدماج القوانين الدولية ضمن السياسات الوطنية”.
وينص الدستور العراقي صراحة على التزام القوات الأمنية حماية حقوق الإنسان وفقاً للمواد 9 رابعاً، و84 أولاً، لكن الإشكالية تكمن في التفاعل التنفيذي مع هذه الالتزامات، فبدلاً من تعزيز الانسجام بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية لا تزال بعض المفاهيم القانونية تعامل بمزيج من الريبة والارتباك، كما حدث مع الجدل حول “اتفاقية سيداو” وحقوق الطفل فيها، مما يؤكد الحاجة إلى وعي قانوني أكثر انفتاحاً على التزامات العراق الدولية.
بين التشريعات والتطبيق
ويؤكد روضان أن “التوافق بين التشريعات العراقية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل من أبرز التحديات القانونية، إذ تُعدّ ’اتفاقية حقوق الطفل‘ لعام1989 أهم اتفاقية دولية لحماية الأطفال، وصادق عليها العراق بموجب القانون رقم 3 لعام1994 ، بمعنى أنها أصبحت جزءاً من النسيج التشريعي الوطني وأصبح تطبيقها ملزماً مثل أي قانون آخر، إلا أن المشكلة لا تكمن في التشريع ذاته بل في كيفية التعامل معه على المستوى التنفيذي”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال “على رغم أن العراق أوفى بالتزامه التشريعي إدراج نصوص الاتفاقية ضمن قوانينه فإن العقل التشريعي والتنفيذي لا يزال يتعامل معها كتشريع غريب عن المنظومة العراقية، وهذه المشكلة لا تقتصر على ’اتفاقية حقوق الطفل‘، بل تشمل جميع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها العراق والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها مفاهيم قانونية دخيلة”.
وزاد أنه “من أمثلة ذلك ما حصل مع ’اتفاقية سيداو‘، إذ شُنت حملة شرسة ضدها على رغم أنها تتضمن مواد تخص حقوق الأطفال وعلاقتهم بالأم، لكن تم التعامل معها كجسم غريب عن النظام التشريعي، ونتيجة لذلك فإن التطبيق العملي لهذه الاتفاقات لا يزال ضعيفاً ومحدوداً، مما يقوض التوافق بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية”.
وخلص بالقول إنه “في هذا السياق يبرز الدستور العراقي كوثيقة ملزمة، فألزم القوات الأمنية ضرورة مراعاة حقوق الإنسان، مما يجعل تنفيذ الاتفاقات الدولية التزاماً دستورياً يعلو على التشريع الوطني، ويؤكد على ضرورة إدماج الاتفاقات الدولية ضمن المنظومة التشريعية العراقية وفقاً لما ورد في المواد 9 رابعاً و84 أولاً من الدستور العراقي”.
دور المؤسسات الحكومية
مديرة الحوار الفكري لشؤون المرأة والطفل ابتهال القيسي توضح أن “الأطفال في العراق يواجهون كثيراً من التحديات من فقر ونزوح وعنف وإجبار على العمل، مما يجعلهم إحدى الفئات الأكثر عرضة للأخطار. وفي هذا السياق تقوم المؤسسات الحكومية، لا سيما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، بدور محوري في توفير الحماية والدعم لهذه الفئة.
وبيّنت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولى مسؤولية رعاية الأطفال المعرضين للخطر عبر تشغيل دور الإيواء ومكافحة عمالة الأطفال وتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة بهدف تقليل تسرب الأطفال إلى سوق العمل. وتشرف كذلك على تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الطفل وتوفر برامج إعادة تأهيل للأطفال المشردين لضمان اندماجهم في المجتمع.
وعن واقع التعليم، أوضحت القيسي أن وزارة التربية تسعى إلى ضمان حصول الأطفال على حقهم في التعليم من خلال سياسات إلزامية التعليم وتطوير مناهج توعوية حول حقوق الطفل ومكافحة العنف المدرسي، وتعمل على تنسيق الجهود مع الجهات الأخرى لضمان بيئة تعليمية آمنة وداعمة نفسياً، بخاصة للأطفال في المناطق التي تأثرت بالنزاعات.
وتابعت أنه “على رغم هذه الجهود لا تزال التحديات قائمة، إذ إن الأمر يتطلب مزيداً من التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتعزيز آليات تنفيذ القوانين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان مستقبل أكثر أماناً للأطفال في العراق”.
ولتعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، استدركت ابتهال القيسي أن الأطفال في العراق يواجهون تحديات متعددة تتطلب استجابة قوية من الحكومة والمجتمع لضمان حقوقهم وحمايتهم. فعلى رغم وجود قوانين لحماية الطفل فإن ضعف التنفيذ والرقابة يجعل عدداً كبيراً منهم عرضة للاستغلال والعنف والتهميش. لذا هناك حاجة ماسة إلى تعزيز تطبيق هذه القوانين وتحسين آليات الرقابة والمساءلة، ومن أبرز التوصيات في هذا الشأن تحديث القوانين وتعزيز تطبيقها.
واقترحت القيسي لضمان حماية فاعلة للأطفال” تحديث التشريعات بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية وتعزيز آليات التنفيذ عبر تدريب الموظفين الحكوميين المعنيين بقضايا الطفل. كما ينبغي تشديد العقوبات على الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال، سواء في سوق العمل، أو داخل المؤسسات التعليمية، أو في البيئات الأسرية”.
ولتعزيز دور الرقابة والمساءلة، قالت إن الحكومة تحتاج إلى إنشاء هيئات مستقلة لمراقبة أوضاع الأطفال وتلقي الشكاوى حول الانتهاكات، مع تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في الكشف عن التجاوزات، ويجب كذلك تطوير أنظمة بيانات وطنية لتتبع حالات الأطفال المعرضين للخطر، مما يسهل التدخل السريع عند الحاجة.
أما عن إصلاح قطاع التعليم وضمان بيئة آمنة وخالية من العنف فيجب، بحسب القيسي، إعادة هيكلة النظام التعليمي مع التركيز على دعم الأطفال الأكثر ضعفاً مثل النازحين والفقراء وتحسين البيئة المدرسية وتدريب المعلمين على التعامل النفسي والتربوي مع الأطفال بما يسهم في خلق مناخ أكثر استقراراً وأماناً لهم.
توسيع برامج الحماية
وتابعت القيسي أن “ما يحدّ من عمالة الأطفال والتسرب المدرسي ويضمن للأطفال فرصاً تعليمية مناسبة هو تقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة، ويجب أن تشمل برامج الدعم الحكومية توفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات النفسية للأطفال الذين يعانون صدمات الحروب والنزوح وإطلاق حملات توعية مجتمعية لرفع الوعي حول حقوق الطفل لمكافحة الممارسات الضارة مثل عمالة الأطفال والتسرب المدرسي والتعنيف الأسري. كما يجب تعزيز ثقافة حماية الطفل والتبليغ عن الانتهاكات من خلال المدارس ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وأردفت أن توفير موارد إضافية لبرامج الطفولة وتحسين الخدمات الأساسية يتطلبان تعاوناً دولياً فاعلاً، وعلى الحكومة العراقية الاستفادة من الدعم الدولي لتطوير مشاريع تعزز من حماية الأطفال وتأهيلهم، بخاصة في المناطق المتضررة من النزاعات.
وأكدت القيسي أن ضمان حقوق الأطفال ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب جهداً وطنياً مشتركاً يشمل الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية، فمن دون تطبيق صارم للقوانين واستراتيجيات شاملة لحماية الطفل سيظل الأطفال في العراق عرضة للخطر والتهميش، مما يؤثر سلباً في مستقبلهم وفي المجتمع ككل، ويجب أن يكون الاستثمار في الطفولة أولوية وطنية لضمان جيل أكثر وعياً وقادر على الإسهام في بناء مستقبل العراق.
من جانب آخر، تشير رئيسة منظمة “زاد الخير” عذراء عبدالأمير إلى غياب الضغط الدولي على الحكومة العراقية لاتخاذ قرارات أو تشريعات تصب في مصلحة الطفل، “بل على العكس شهدنا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتيح زواج القاصرات في سن التاسعة، مما يشكل انتكاسة خطرة لملف حماية الطفولة.”
ويقول استشاري السلوك المعرفي فاروق الدباغ إنه “على رغم امتلاك العراق منظومة قانونية تهدف إلى حماية الطفل، فإن الفجوة بين التشريع والتطبيق لا تزال كبيرة، مما يترك الأطفال عرضة للاستغلال والإهمال في ظل بيئة تفتقر إلى آليات التنفيذ الفاعلة”.
ويضم الإطار القانوني العراقي، بحسب الدباغ، كثيراً من التشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل، مثل قانون رعاية الأحداث وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون العقوبات. كما التزم العراق “اتفاقية حقوق الطفل” الدولية، لكن عدداً كبيراً من هذه القوانين يعود لعقود سابقة ولم تُحدّث لمواكبة التغيرات المجتمعية، ولا توجد نصوص قانونية فاعلة لمكافحة استغلال الأطفال في سوق العمل، أو لحمايتهم من التشرد بصورة شاملة، مما يترك مساحة واسعة للانتهاكات من دون مساءلة قانونية حقيقية.
الفقر والجهل والجريمة
أما من الجانب التطبيقي، فيوضح أن “ضعف المؤسسات التنفيذية وغياب الإرادة السياسية وانتشار الفساد الإداري عوامل تعرقل تطبيق القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعانيها الأطفال. وعلى رغم وجود قوانين تمنع عمالة الأطفال، فإن المشهد اليومي في الأسواق والشوارع يعكس واقعاً مختلفاً، حيث يُجبر الأطفال على العمل في ظروف قاسية بدلاً من التوجه إلى المدارس، كما بات الاستغلال الجنسي للأطفال أيضاً ظاهرة مقلقة في ظل غياب منظومة حماية فاعلة، في وقت تعاني الدولة غياب برامج تأهيلية للأطفال المشردين”.
ووصف الدباغ الأثر المجتمعي لضعف تطبيق قوانين حماية الطفل بأنه “كارثي، إذ يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر واستدامته بين الأجيال نتيجة حرمان الأطفال من فرص التعليم التي تمكنهم من بناء مستقبل اقتصادي أفضل. كما يسهم إهمال التعليم في انتشار الجهل وسط الأجيال الجديدة، مما يجعلهم عرضة للمعلومات المشوهة التي تروجها بيئات غير منظمة. فارتفاع معدلات الجريمة هو نتيجة حتمية لهذا الإهمال، ويصبح الأطفال المهملون أكثر عرضة للانضمام إلى أنشطة غير قانونية إما كضحايا أو مجرمين بسبب غياب الأمان الأسري والتعليمي”.
ووفق الدباغ، “تشكل هذه العوامل حلقة مفرغة تكرس التدهور الاجتماعي، إذ يؤدي الإهمال التعليمي إلى ضعف القدرات المعرفية للأطفال مما يحدّ من إمكاناتهم المستقبلية، والاستغلال الاقتصادي للأطفال يدفعهم إلى سوق العمل في سن مبكرة مما يعوّق تطورهم المهني، بينما يتسبب التفكك الاجتماعي في غياب الأمان العاطفي والهوية الأخلاقية وزيادة احتمالات الانحراف السلوكي والجريمة”.
أما عن السياسات الحالية وتأثيرها في حماية الطفل، فيوضح أن “السياسات الحالية تفتقر إلى رؤية شاملة، فلا تزال التشريعات مصاغة بأسلوب بيروقراطي لا يعكس حاجات الطفل في القرن الـ21 لأن تآكل مؤسسات الرعاية وانحرافها عن دورها الأساسي يجعلانها غير قادرة على تأمين بيئة صحية للأطفال، أما غياب الإرادة السياسية فيجعل القوانين غير ذات تأثير حقيقي، ويتم تجاهل الإصلاحات الضرورية التي من شأنها تحسين أوضاع الأطفال”.
وتُعدّ عمالة الأطفال واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه العراق، حيث يُجبر كثير منهم على العمل في الأسواق أو ورش تصليح السيارات أو التسول في الشوارع بسبب الفقر، وفي بعض الحالات تتولى شبكات منظمة إدارة هؤلاء الأطفال وتحقيق أرباح من استغلالهم. أما الاستغلال الجنسي للأطفال فيمثل كارثة أخلاقية أخرى، إذ تشير تقارير إلى تورط بعض الجهات في تجارة الجنس للأطفال وسط غياب الرقابة والمحاسبة القانونية، والتخلي عن الأطفال بسبب الفقر يدفع كثيراً من الأسر إلى إيداعهم دور الأيتام أو تركهم في الشوارع، مما يجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات والاستغلال.
ويقول فاروق الدباغ إن “الطفل ليس ملكاً لوالديه، بل هو كيان مستقل يتمتع بحقوق إنسانية تضمن له حياة كريمة وفرصاً متكافئة للنمو والتطور، لكن الفكر التقليدي في العراق لا يزال ينظر إلى الطفل على أنه امتداد للأسرة وأداة لخدمتها، مما يعوّق تحقيقه لذاته ويفرض عليه أدواراً لا تتناسب مع عمره وحاجاته”.
وحول دور الإعلام والمدارس في تشكيل الوعي، فسر الدباغ أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً رئيساً لتلقي المعلومات بالنسبة إلى الأطفال، لكن غياب الرقابة يجعلهم عرضة لمحتوى مشوه يؤثر في وعيهم وسلوكهم، والمدارس من جانبها لا تقدم سوى تعليم أكاديمي تقليدي من دون تركيز على تطوير المهارات الفكرية والعاطفية والإبداعية للأطفال، مما يجعلهم غير مؤهلين للتعامل مع تحديات العصر.
واقع أم غياب للإرادة؟
ويرى المتخصص القانوني وليد الشبيبي من جانبه أن “العراق يُعدّ مهد القانون، فمنه خرج أول تشريع قانوني في التاريخ، ومع ذلك فإن حماية حقوق الطفل، على رغم وجود منظومة قانونية رصينة، تواجه تحديات التطبيق والتنفيذ الفعلي. والدستور العراقي، من خلال المادتين 29 و30، وضع أسساً واضحة لحماية الطفل والأسرة، كما عزز قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام1959 هذه الحماية ليصبح أحد أفضل القوانين في الوطن العربي في هذا المجال”.
إلى جانب ذلك، حدد قانون رعاية القاصرين رقم78 لعام 1980 سن الرشد المالي بـ15 سنة، في حين حدد قانون العمل الحد الأدنى لسن العمل بـ15 سنة، مجرّماً بذلك عمالة الأطفال. أما قانون العقوبات فجرّم التسول، بخاصة حين يكون الأطفال ضحاياه بسبب شبكات تستغلهم لاستدرار عواطف الناس. كما أن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام1983 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر أسهما في الحد من استغلال الأطفال بطرق مختلفة.
وعلى الصعيد الدولي، التزم العراق كثيراً من الاتفاقات الدولية مثل “اتفاقية سيداو”، لكنه تحفظ على بعض النصوص التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، في حين التزم تلك التي تعزز حماية الطفل والمرأة.
ومع ذلك يؤكد الشبيبي أنه على رغم هذا الإطار القانوني المتين، يعاني العراق ضعفاً في التطبيق بفعل الحروب والأزمات السياسية والأنظمة الديكتاتورية التي حكمته، مما أدى إلى إنهاك المجتمع وشل قدرة الدولة على فرض القوانين، فالمدارس تفتقر إلى المناهج التربوية التي تزرع القيم السليمة، ولم يبدأ العراق بعد بإصلاح حقيقي للمؤسسات التعليمية والتربوية لأن الأزمات السياسية ألقت بظلالها الثقيلة على حقوق الطفل، وتكشفت ظواهر اجتماعية جديدة مثل جيوش الأطفال المتسولين، فلم تعُد هذه الظاهرة استثناء بل باتت جزءاً من المشهد اليومي وسط شبهات بوجود مافيات تدير هذه الشبكات مما يتطلب تدخلاً حاسماً من الجهات الأمنية.
وأضاف أن ارتفاع نسب الطلاق أسهم في تفكك الأسرة وانهيار القيم الأخلاقية، مما جعل الأطفال في مهب الريح بلا حماية كافية، وهنا تبرز مسؤولية الحكومة والسلطة الحاكمة في إيجاد حلول حقيقية، وليس الاكتفاء بالشعارات خصوصاً مع وجود وزارات عاجزة عن أداء واجباتها على رغم إمكان الاستعانة بخبراء في المجال.
ويقول الشبيبي إن ما يحتاج إليه العراق اليوم ليس فقط سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة وإعادة بناء منظومة اجتماعية واقتصادية توفر بيئة صحية للطفل، وتبدأ من إصلاح التعليم ومكافحة الفقر ومحاربة التسول المنظم، بدلاً من إنتاج جيش جديد من العاطلين من العمل، مؤكداً أن “حماية الطفل ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل المجتمع ككل، بدءاً من نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل، مروراً بتفعيل الرقابة الحكومية وانتهاء بإصلاحات اقتصادية توفر بيئة آمنة ومستقرة للأسر”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية