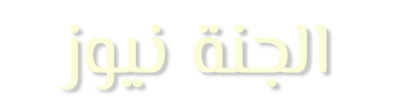لم تترك الصفوة السودانية جنباً من خطاب الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، في الـ17 من فبراير (شباط) الجاري “يرقد عليه”، كما نقول عمن تكاثر عليه الطعان، لكنهم أضربوا عن الفقرة التي تخصهم من دون غيرهم إضراباً.
كان البرهان طلب في معرض حديثه أن يخصب الناس بالنقاش بصور ذكرها في وثيقة عن خريطة طريق للسودان خلال الحرب وما بعدها، وزاد أن يحسنوا للسياسة بـ”مراكز بحوث ومراكز دراسات أيضاً”، مشيراً إلى أننا نعاني الضعيفين في مجال البحوث والدراسات. فعلمنا في قول “من رأسنا لا من كراسنا ونتكففه من غيرنا، فنريد عمل مراكز دراسات. وكنا بدأنا بعملها وفشلنا وتكررت المحاولة وتكرر الفشل. فالسودان غني بتراثه وتاريخه وتجاربه وخبراته”. وأضاف عن الحاجة إلى أبحاث اقتصادية واجتماعية بناءة نمزج فيها ما بين واقعنا وواقع غيرنا.
استدبرت الصفوة هذه الدعوة إلى البحث التي هي من صميم وصفها الوظيفي، فقام الأداء في الدولة على “ممارسة السياسة” لا “إنتاج السياسة” في قول الإعلامي فوزي بشري. وتمثلت ممارسة السياسة في عادة المبادرات التي تتبرع بها جماعة من الصفوة للدولة في بحث الجماعة عن مكان في دولاب حكومتها، في حين أن إنتاج السياسة، في تعريف فوزي، نشاط متصل بعالم الأفكار والرؤى والتصورات المتجاوزة لركام الأفكار التي صنعت سودان ما قبل الحرب. وكان المثقف غادر معمله في إنتاج الأفكار منذ عقود حين تعاقد طوعاً مع البندقية المعارضة أو الحاكمة في هجرات بدأت للحركة الشعبية لتحرير السودان (1983)، ولا تزال كما تراها في مؤتمر الحكومة تحت التكوين في مناطق سيطرة قوات “الدعم السريع”، وهي هجرة تخلص المثقف بها من وكد إنتاج المعرفة إلى الخدمة المعرفية لمسلح.
فلا يملك قارئ وثيقة “المشروع الوطني” التي نوه بها البرهان في كلمته إلا التساؤل إن لم تكُن هي من عهد ما قبل الحرب نفض أهله عنه الغبار. فلا ذكر فيها للحرب الناشبة ليومنا التي ننتظر منها رسم خريطة الطريق لنا بعدها إلا في صفحة 3 (وقف الحرب) ثم صفحة 4 (البدء بالإعمار) و7 (ملاحقة من أشعلوا الحرب) و8 (إعادة الإعمار) على الأفراد بينما جاء ذكر الحروب المناطقية التي سبقت في مقدمة الوثيقة.
قالت الوثيقة في مقدمتها إن غياب المشروع الوطني ساق إلى “سلسلة من الحروب الأهلية في أطراف البلاد”. فلم يتفق للوثيقة، وهي تذكر الحروب التي سبقت من دون ذكر حربنا القائمة، أن هذه الحرب جبت ما قبلها لا بإلغائها، بل لأنها هي جماعها. فيعشعش في الوثيقة لا يزال هاجس قضايا كانت مقدمة في صراعات ما بعد الثورة. فتجد فيها ذاكرة حروب دارفور متقدة حية في مثل قولها “تعزيز فرص السلم الاجتماعي في دارفور والمناطق المتأثرة بالنزاعات والحرب” و”توطيد أركان العدالة والسلام والمصالحة لفترة ما بعد النزاعات المسلحة” ورد “الاعتبار الأدبي والمعنوي للضحايا من قبل الدولة” وتنفيذ اتفاق جوبا ومعالجة قضية شرق السودان عبر المنبر التفاوضي الذي قرر قيامه اتفاق جوبا. وتلك معالم خريطة طريق عفا عليها الدهر وصرنا في حال آخر. ومع ذلك لم تمسح الحرب في يومنا هذه المسائل من الخريطة، ولكن بوبتها في أزمة وطنية أعرض لا تنتقص منها مقدار خردلة إن لم تزِدها سطوعاً وإلحاحاً.
لا يفوت على قارئ الوثيقة تشوشها لنقلها من نص قديم نفضت عنه الغبار لتعالج وضعاً ليس مستجداً فحسب، بل منذراً بذهاب ريح البلد. فقالت بفترة انتقالية قسمتها إلى فترتين، الفترة التأسيسية الانتقالية والفترة الانتقالية. فتقوم الفترة التأسيسية فينا لعام بعد الحرب ثم تعقبها الانتقالية لمدة من الزمن تتقرر في “الحوار السوداني-السوداني” الذي سيعقد في الفترة التأسيسية.
وهنا يبدأ التشوش لأن الوثيقة ألقت على عاتق الفترة العاقبة للتأسيسية، أي الانتقالية، مهمة عقد المؤتمر الدستوري وصياغة الدستور الدائم للبلاد، ولكنك لو عدت لمهمات الحوار السوداني-السوداني في الفترة التأسيسية الانتقالية لوجدتها هي نفسها ما ينتظر تداوله في المؤتمر الدستوري. فسيناقش مؤتمر الحوار السوداني-السوداني طبيعة الدولة وشكل ونظام الحكم والهوية وقضايا الحكم والإدارة وقوام الدولة في الاقتصاد والاستثمار ومبادئ تقاسم الثروة والسياسة الخارجية وكرامة وحقوق الإنسان وغيرها. فماذا ترك الحوار السوداني-السوداني في الفترة التأسيسية من مسائل ليتداول فيها المؤتمر الدستوري المكلف صياغة دستور البلاد في الفترة الانتقالية؟
من جهة أخرى لم تترك الوثيقة لا شاردة ولا واردة من المبادئ السياسية العامة الغراء لم تذكره، فجاء فيها مثلاً وجوب قيام نظام ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب ويضمن المشاركة السياسية العادلة لجميع المكونات، وهذا التعبير والمشاركة ما وفقت فيه كل الانتخابات البرلمانية منذ عام 1954 إلا اضطراراً في بعض حالات جنوب السودان لظرف اضطراب حبل الأمن فيه خلال انتخابات عام 1965 وعام 1986.
وبالطبع لن تجد من يختلف مع هذه المبادئ إلا أن ما استحق الوقوف عنده حقاً فهو لماذا كان دوام هذا النظام البرلماني فينا محالاً. وهو الإشكال الذي لم يغِب عن الوثيقة نفسها بإشارتها إلى “الدورة الشريرة التي تمثلت في قيام حكومات ائتلافية تعجز عن حسم القضايا الخلافية”، فتؤدي إلى انقلابات عسكرية تنتهي بثورة أو انتفاضة شعبية. وصارت هذه “الدورة الشريرة” فينا كدورات الطبيعة لا من ديناميكيات السياسة، فنقول بها كأنها مما يستعصي على التشخيص والعلاج معاً. فتقرير مبدأ إحلال الديمقراطية فينا من دارج ممارسة السياسة أما إنتاجها ففي تحليل هذه “الدورة الشريرة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
صدر في أعقاب بيان البرهان من جهة أخرى بيان من المؤتمر الوطني هو ممارسة سياسية عادية خلا هو أيضاً من عادة إنتاج المعرفة، فبدا مهجوساً بأمرين. أما الأمر الأول فهو تأكيد موقفه من أن تقرير مصير الشعب استحقاق للشعب “وأنه لا صلاحية لحزب واحد، أو حتى كل الأحزاب، أو أي جهة أخرى أن تقرر لوحدها في أمره”، وهذا بمثابة لفت نظر للبرهان الذي قسى على المؤتمر الوطني في خطابه لحفاوته بوثيقة “المشروع الوطني” وتمييزها كالأصل الذي سيغتني بآراء الآخرين. أما الهاجس الثاني فهو شبح الاستثناء من العملية السياسية الذي طارده.
وبدا من بيان المؤتمر الوطني أنه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى من دون التصالح مع حقيقة أنه ممن خلعته ثورة، أو بأي اسم كما قال البيان، عن حكم دام لثلاثة عقود طوال. فقال المؤتمر في البيان أنه قرر فتح الحوار بصورة موسعة حول خريطة طريق للوطن “داخل حزبنا ومع كل الأحزاب والرأي العام السوداني”، بل إنهم “أنجزوا مراجعات مهمة وعميقة لتجربتنا في الحكم وقفنا فيها على إيجابياتها وسلبياتها بكل موضوعية وشجاعة وجرأة وجارٍ الآن تحريرها وسيتم تداولها مع كل عضويتنا ونشارك الآخرين والرأي العام” طلباً ليهديهم الناس عيوبهم، ولكن ما عتم أن بان تمنع المؤتمر الوطني على هذا النقد الذاتي. فذكروا “حوار الوثبة” مع طوائف من القوى السياسية (2015) كسابقة ذكية لهم في إدارة الحوارات مع الآخر بشرف. وربما لم يجد الإسلاميون كثيراً من بين السودانيين من يشاركهم رأيهم الحسن في ذلك الحوار، وخلافاً لذلك سيجدون إجماعاً ربما على أنه كان الطريق القصير للخدعة السياسية.
من جهة أخرى وجد الإسلاميون في فشل الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد الإطاحة بهم عاذرة لهم من أخذ أنفسهم بالشدة في طريق النفس اللوامة، وهي حال غراء من إنتاج المعرفة. فما طرأ لهم وجوب نقد أنفسهم ذاتياً حتى وجدوا في تهافت الحكومة الانتقالية ذريعة للقول إنهم كانوا الأفضل بالمقارنة. فقالوا إنهم قبلوا بعد إزاحتهم عن الحكم بعد الثورة بالقيام بدور “المعارضة المساندة”، ولكن كانت الانتقالية اختطافاً كاملاً للوطن بواسطة الأجانب وتشاكس بين أطرافها على “كيكة السلطة”. وعمدت إلى “فرض قوانين وتشريعات ودستور ومناهج تعليم ومنظومة قيم اجتماعية وثقافية دخيلة على موروثنا”. وجرؤت على تفكيك مؤسسات الدولة السودانية الدفاعية والأمنية والعدلية والخدمية تحت دعاوى تفكيك التمكين”، ولما حاق بها الفشل من كل جهة لجأت إلى الاتفاق الإطاري وهددت إما بالقبول به أو الحرب.
فإذا كان هذا ديدن الإسلاميين حيال ارتكابهم الحكم في غير ما موعد ولا شرعية فسيطول بهم الزمن من دون أخذ فشل تجربتهم في الحكم باستقلال عن فشل الحكومة الانتقالية، ففشل الأخيرة لا نفاد له، وهذه ممارسة للسياسة كما قال فوزي لا إنتاجاً للسياسة يجدد بها الإسلاميون الدم في عروقهم وعروق الوطن معاً.
أما حال صفوة الفكر التي تقاطرت على نيروبي خلال الأسبوع الماضي لتكوين حكومة في المناطق الواقعة تحت السيطرة فهي من عادة السياسة عندنا منذ عقود التي يعرض المثقف، سود الصحائف، خدماته لمسلح، بيض الصفائح، بلا قيد أو شرط. وعرضهم هذه المرة “مبالغة” كما يقول السودانيون لأنهم يأتون بحكومة لحركة كـ”الدعم السريع” هي نقيض الحكومة كما رأينا منها لعامين خلال الحرب.
فتجد رموز هذه الحكومة الموعودة يلجون حول طبيعة علاقتهم مع “الدعم السريع”، فلا يفهم المرء من وزير العدل في الحكومة الانتقالية الدكتور نصر الدين عبدالباري إن كانت جماعة نيروبي بصدد تكوين حكومة تمثل قوى عسكرية تخوض حرباً ضروساً أو إنها منظمة إغاثة ملحقة بهذه القوة. فقال عبدالباري إن الفكرة من وراء تكوين الحكومة ليست خوض الحرب التي لا يملكون عدتها. فعلاقتهم مع “الدعم السريع”، في قوله، مبنية على “التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية من أجل توفير الخدمات للمواطنين (في مناطق سيطرة “الدعم السريع”) وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم في كل جهد لإيقاف الحرب”. وزاد بقوله إنه غير مشغول بسؤال شرعية حكومتهم المقبلة لأن صون كرامة الإنسان فوق الاعتبارات السياسية.
لكن للدكتور النور حمد، مؤلف كتاب “العقل الرعوي”، خطة للحكومة المرتقبة أكثر طموحاً، فالحكومة عنده هي إرادة ما بقي من القوى المدنية التي انهارت دعائمها والتي لا تزال تحمل لواء ثورة ديسمبر (كانون الأول) عام 2018. فهي ليست حكومة “الدعم السريع” وكل ما حدث أنها قامت في أرض تحتلها “الدعم السريع” التي هي القوة الوحيدة التي وقفت بوجه الفلول، الإسلاميين، لتقتلع أراضي السودان منهم. فالحكومة المنتظرة طرف في حلف عسكري مدني لاستعادة السودان من الفلول لا بالهتاف ومن منصات المهاجر.
وصدر النور في هذا عن سوء الظن في القوى المدنية الممثلة في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”. فتغير المسرح، في قول النور، فلا مجال للحديث عن سلمية الثورة بل لا بد من شق طريق آخر يخرج فيه المدني الذي بلا شوكة ليتحد مع قوة عسكرية كما يفعل الجيش والفلول بينما تضرب الفرقة الجماعات المضادة لهم. وانتهى في توصيف علاقتهم مع “الدعم السريع” بمقاربة مع “الحركة الشعبية لتحرير السودان” و”الجيش الشعبي لتحرير السودان” بقيادة العقيد جون قرنق في أوائل الثمانينيات. وهي مقاربة توثق عراهم مع ذلك بـ”الدعم السريع” بغير ما أراد النور ربما. فلم تكُن الحركة الشعبية شئياً آخر غير الجيش الشعبي إلا من ناحية الوظائف تحت قيادة سياسية واحدة، بل تحت العقيد قرنق أبداً.
ولا يتفاءل المرء بأن يكون للحكومة المرتقبة للصفوة تأثير حسن في “الدعم السريع” من جهة التزام قانون الحرب الإنساني. فالنور يعترف بارتكاب “الدعم السريع” لتجاوزات في حربه ضد القوات المسلحة وهي عنده موجبة للمساءلة. وبينما يصعب الدفاع، في قوله، عن “الدعم السريع” إلا أن من صحت مؤاخذته حقاً فالقوات المسلحة التي أشعلت الحرب. فالأولى تحميل وزر التعديات لمن أشعل الحرب بدلاً من التمسك بتفاصيل التعديات التي لا سيطرة لمرتكبها عليها. فالحرب تخلق أوضاعاً ينهار فيها القانون وتلغي دولة و”من غلب سلب”. وبدا النور كمن يقول “لا تحلموا بعالم سعيد”. فالحرب على علاتها محكومة بأعراف لا يبدو أن حكومة “الدعم السريع” تهيأت للالتزام بها في دولتها.
لطلاق الفكر عن السياسة تاريخ طويل ينظر في ظرف آخر، ولكن دعوة البرهان إلى “احتواء الأزمة بالبحث” في عبارة سديدة للدكتور آدم الزين لافتة بوجهين، صدورها أولاً من عسكري في خضم حرب ضروس وتجاهل الصفوة لها كأنها لا تعنيهم.
نقلاً عن : اندبندنت عربية