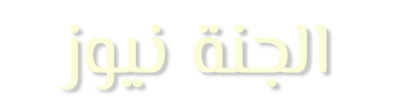قرر عزت القمحاوي أن يبدأ رحلته الجديدة، من حيث توقفت رحلة سرديته السابقة، فالبطل الذي تعرض للاعتقال حين أقدم على تصوير قِطيْن يمارسان الحب خلف أسوار قسم الشرطة، تتوحش مخاوفه فيحتمي بعزلته في شقته في حي غاردن سيتي وسط القاهرة. وبعد ما يزيد على شهرين، يستسلم أخيراً لطرقات فوق بابه ويستجيب لرسالة يأتي بها غلام ريفي، يخبره أن له بستاناً في قرية “تل المساخيط”.
يذهب “سامي” إلى القرية مدفوعاً بإلحاح ذاكرة؛ تحمل مشاهد من ماضٍ بعيد، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته، لا يغادرها الخوف، وإن زاحمته مشاعر الحب والرضا والفقد والحزن والصراع. يشبه البطل منحوتة فنية أبدعها صانعها، وقدّر لها الكمال، فقد منحه الكاتب صفات إنسانية فريدة، فهو حالم حليم نقي حدَّ الكشف ناصع حدَّ أن تألفه حيوانات لا تعرفه، رقيق حدَّ أن تعذب روحه شرور العالم، من دون أن تحمله على مخاصمة الحياة .. هذه السمات التي تبتعد بالشخصية المحورية عن الملامح المعهودة للبشر؛ تبرر السرد المركزي، الذي انتهجه الكاتب مانحاً سلطة الحكي لراوٍ عليم، يبرز مثالية البطل. ويحيط بما يحدث داخله، وحوله ويرصد رحلته من شقته في غاردن سيتي إلى سرايا “أم الغلام” في “تل المساخيط” القريبة من مدينة “سراب”.
هذا الفضاء المكاني المتخيَّل، الذي يحيل ربما إلى أماكن واقعية في شمال مصر؛ يجسد الكاتب من خلاله ملامح القرية المصرية، ينقل خصوصيتها كبقعة مهمة تعبر عن الهامش ويخبر بمآسيها وصراعاتها، كما يضيء عبر ما ينسجه في فلكها من علاقات؛ دواخل بطله ويتيح استكشاف طبيعته السيكولوجية المتفردة، متتبعاً ما خلفته قسوة العالم في طبقات نفسه الأعمق، من خوف تنوعت دوافعه وغذَّاه مناخ فاسد، مع ذاكرة مكتظة بمشاهد البطش والظلم والامتهان، مما جعل شتاء البطل نفسه لصيقاً بالخوف، منذ أن اخترقت رصاصة قنَّاص جبهة أخيه في شتاء، واعتُقل هو في شتاء آخر، حتى حلّ شتاؤه في “تل المساخيط”، مصحوباً بمطامع جاره صاحب النفوذ والعلاقات: “كان من الممكن أن يكون هذا الفصل شتاء سامي السعيد الثاني، فلولا وجود أمين عسكر في الجهة الأخرى من المدق، لاعتقد أن الشتاء خالف طبائعه بعد أن أذاقه كل صنوف الخوف والحزن” ص355.
خصوصية المكان
جمع الكاتب بين القرية والمدينة كفضائين مكانيين للسرد، غير أن القرية استحوذت على المساحة الأكبر، ولم تكن وعاءً للأحداث وحسب، بل كانت مدخلاً سلكه الكاتب لرصد التحولات، التي طرأت على الريف المصري، ولطرق قضايا الواقع الشائكة مثل المحسوبية، البيروقراطية، الغش، الرشوة، الفساد، القمع، تلفيق التهم، الوصولية، استغلال النفوذ، التدين الزائف والنفاق الديني، الهجرة غير الشرعية، تراجع الثقافة، اضمحلال الفكر، التعامل مع “السوشيال ميديا” كشاشة عرض للحياة الخاصة، الطبقية، سوء الإدارة والتخطيط، شيوع القيم الاستهلاكية وارتباطها بالمظهرية والتفاخر: “أخذت تعدد لفريدة ما يجب أن تشتريه لجهاز عرس ابنتها: غسالتان، صغيرة وكبيرة، ثلاجة وديب فريزر، سجاد، ومن مفارش السرير 40، ومثلها المناشف والبيجامات، غير أثاث غرفة، وأثاث وأدوات المطبخ، وقبل كل هذا يرسل العريس في الخطوبة بخروف هدية، وترد أسرة العروس بموتوسيكل وأحياناً بتوكتوك” ص 327.
رصد القمحاوي ملامح البيئة الريفية، تارة عبر الوصف واللغة المشهدية، وتارة عبر استدعاء مكونات القرية، وإبراز خصوصيتها، إذ عمد إلى تصوير الحضور الكثيف للحيوان، ورصد العلاقة الحميمية التي تربط القروي به، كما نقل صورة لطبيعة العلاقات الاجتماعية في الريف التي يشوبها فضول لا يلتفت إلى خصوصية أو حدود. وحرص على مراعاة مقتضى الحال في سرده، لا سيما في لغة الشخوص، فجاءت لغة “الجدة” مغلفة بالحدة والصرامة والسباب، في حين عبّرت لغة “سمعان” عن عقله المعطوب، ووسمت كثرة القسم؛ لغة تجار الماعز أثناء عمليات البيع والشراء، على نحو يطابق الواقع ويحاكيه.
ثنائيات وصراعات
عمد الكاتب إلى رصد تناقضات العالم وثنائياته المتقابلة التي تراوحت بين الحاضر والماضي، الواقعي والافتراضي، الموت والحياة، الصدق والادعاء، وكذا الثنائية التقليدية للخير والشر التي حفز قطباها حال الصراع بالنص، مما أسهم في دفع الأحداث وتحريكها، فكان الصراع بين الجدة فوزية “أم الغلام” وأبناء عمومة ابنها المقتول بيد أبيهم، سبباً في استدعائها للبطل “سامي”، وإعادة منحه السرايا والأرض ذاتها، التي وهبها لها جده “سالم باشا يعقوب” طوعاً بعد إقرار قانون الإصلاح الزراعي ضمن أراض قام بتوزيعها على كل الفلاحين.
وكان الصراع بين “سامي” و”أمين عسكر”، وسيلة؛ لا لدفع الحدث نحو التنامي الدرامي وحسب، ولكن أيضاً لاستجلاء التحولات الاجتماعية والسياسية، التي طرأت على المجتمع المصري، وتصوير نتاج استغلال السلطة في توطين الفساد، والتحايل على القانون: “فلسفة التشريع في مصر منذ 70 عاماً تقوم على كلمة ممنوع، وتترك بجوارها ثغرة صغيرة، تمنح الموظف حق تفسير القانون، وجعل الممنوع مسموحاً لقاء رشوة” ص 310. وإلى جانب بروز الصراع الخارجي، ازدحمت نفس “سامي” بصراعات داخلية، اندلعت بين حبه لـ”فريدة” ووفائه لها، وإعجابه بـ”نعمة” وافتتانه بجسدها، وبين رغبته في إنهاء خدمة العامل الكسول، وخوفه عليه من هلاك أبصره، في لحظة كشف صوفية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضفى الكاتب عبر الصراع بعداً سيكولوجياً للسرد، فرصد من خلال الصراعات الداخلية نقاء البطل الذي لم تلوثه الحياة، كما عمد لرصد أثر الصراعات الخارجية فيه، وما أسفرت عنه من مشكلات وحيل نفسية، لا سيما مشكلة “النكوص”: “صار يشرد كثيراً، ويبالغ في الضحك على أشياء بسيطة، ثم يسكت فجأة كما لو أن يداً أطفأت زر تشغيله، ثم بدأ فتوره تجاهها، وعندما يستلقي بجوارها يشرع في مص أصابعه حتى يستغرق في النوم مبتسماً، ويكلم نفسه في الحلم” ص 374.
وكانت الصراعات بكل مستوياتها؛ مقدمة للتحول الذي بات ثيمة رئيسة للسرد، ليس على المستوى النفسي والاجتماعي والسياسي وحسب، وإنما التقط الكاتب صوراً أخرى للتحول، منها ما يتصل بتراجع المناخ الثقافي، والانتقال من الثقل إلى الخفة والسطحية، ومنها ما يتصل بالبيئة والفضاء المكاني للأحداث، مثل تحول حيوانات المعلف بين زيادة ونقص، صحة ومرض، وكذا تحول البستان وموت أشجاره، وغياب الفضاء الأخضر الممتد أمام السرايا، بعد نمو الحائط الخرساني لفيلا “أمين عسكر”، وتحول أقارب “أم الغلام” من أعداء إلى أصدقاء، بعدما اكتشفوا تلاعب “عسكر” بهم، ومن أصحاب حيازة إلى فقراء، بعدما تخلوا عن أرضهم بالبيع.
النوبة والرمز
عمد الكاتب إلى إحياء جانب من الهوية الثقافية عبر استدعاء التراث النوبي، وما نثره من أغانٍ نوبية في طيات النسيج، وتطرق ضمناً إلى أثر تهجير سكان النوبة بعد بناء السد العالي، وجسد هذا الأثر في شخصية “حمادة” الصامت الحزين، الذي اعتاد أن يخفي ألمه ولا يصدح إلا بغناء، لا تعي الشخوص معانيه.
وتعمد “القمحاوي” عدم الإفصاح عن تلك المعاني للقارئ، في إشارة ضمنية إلى أن ألم النوبيين والضرر الذي وقع عليهم لم يتفهمه أحد. وكما وظف الأغنية النوبية للإحالة إلى دلالات رمزية، عمد إلى الرمز أيضاً عبر اختياره أسماء الشخوص، لا سيما شخصيتي “سامي” و”أمين عسكر”.
ومن جهة أخرى رصد الاستغلال السيئ للرمز الديني والوطني، ومحاولات الاستفادة من دلالاتهما في إخفاء الجرائم، التي تحول أسلوب التستر عليها، من بناء مسجد، إلى تلوين جدار بألوان العلم! كذلك عمد إلى الاستفادة من رمزية الحلم، لتمرير تأويلاته ورؤاه، فأحال حلم البطل بحملان بيضاء، تغطي ميدان التحرير، وقيام رجال ملثمين بقتلها، إلى قمع البراءة والأمل، وإزهاق الحلم بالتغيير، وكذا الميراث الثقيل من الخوف والخيبة، الذي خلّفه ضياع الحلم، وإضافة إلى دورها التفسيري، لعبت الأحلام دور النبوءة والاستبصار، فمهدت لموت كلاب السرايا مسممة، كما كانت وسيلة لدعم النزوع الصوفي بالنص، إذ كانت واحدة من وسائل البطل لكشف الحجب والاستبصار.
وقد سمح الكشف في صوره كافة؛ للقارئ بالمشاركة في لعبة السرد، عبر إطلاق يده في كيفية التعاطي معه، إما بوصفه حقيقة تحملها أحشاء الواقع على رغم غرابتها، أو درباً من دروب الفانتازيا الخالصة، خاصة بعدما تكشف عن أن الغلام الذي حمل الرسالة إلى البطل هو نفسه الفتى المقتول، ولم يكن الحلم رافداً وحيداً لتيار الوعي، إذ أفرد الكاتب مساحات شاسعة للمونولوغ الداخلي، في إشارة إلى ثراء عوالم موازية، مخبوءة في دواخل البطل، يحجبها الصمت؛ ويسهم المونولوغ إلى جانب الحلم؛ في استجلاء أسرارها. كذلك وظف الدور التمهيدي للحلم، في صنع نهاية مفتوحة تدفع القارئ للمشاركة من جديد في لعبة السرد، وتقرير مصير الشخوص بعدما قدم له إجابات عن أسئلة شائكة، مثل لماذا أخفقت ثورة يناير؟ وبعدما وضع بين يديه زخماً من الرؤى حول الخوف، الموت، الفقد، وصيرورة الحياة.
نقلاً عن : اندبندنت عربية