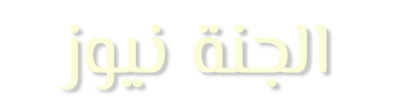أخيراً فتح الملف المسكوت عنه عراقياً منذ 70 عاماً، إذ أعلنت حكومة محمد شياع السوداني إعداد النموذج الاستثماري لأول مرحلتين بـ”مدينة الصدر” الجديدة، مدينة الثورة سابقاً، وتتضمنان 60 ألف وحدة سكنية، كنواة بديلة عن المدينة الإشكالية القديمة، يراها كثير من المتخصصين محاولة متواضعة لسبر أغوار أكبر وأعقد ملف يواجه السلطات العراقية المتعاقبة، منذ الحكم الملكي حتى الآن، لكونه يتعلق بظاهرة الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة.
صراع الريف والمدينة
الصراع الحضاري المحتدم في المدن العراقية بين الريف والمدينة، تمثل بظهور الأحياء الشعبية التي تكاد تطوق البيوت الحديثة، مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لاسيما في العاصمة التي يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من ربع سكان العراق البالغ 42 مليون نسمة، فالحاجة الفعلية إلى تخفيف أعباء المدينة المكتظة وبناء بديل عنها تتطلب مئات الألوف من الوحدات السكنية الجديدة التي تحل محل الحالية.
ويقطن الأعم الغالب من سكان العاصمة في شرق بغداد بـ”مدينة الصدر”، بمعدل ستة أفراد في البيت الواحد، بمتوسط مساحة 150 متراً مربعاً للأسرة الواحدة، جلهم من أصول ريفية، حلموا ذات يوم بالسكن اللائق في عاصمتهم بغداد، بعد أن مكثوا قرابة عقد الخمسينيات في (الصرائف)، وهي نوع السكن العشوائي غير القانوني، خارج التصميم الأساس لمدينة بغداد، الذي وضعه باشوات بغداد إبان الحكم الملكي بحرفية أهم المصممين العالميين، لمناطق لم تكن مخصصة للسكن بالأصل، في فضاءات بغداد القريبة من بيوت الباشوات وموظفي الحكومة.
لم تستوعب حكومات الحقبة الملكية أزمة انهيار الإقطاع العراقي، بعد الحرب العالمية الأولى وتفاقمه في الحرب الثانية، وهرب المزارعين من بطش الإقطاع وقسوته إلى المدن العراقية للتكسب والعيش والتقرب من المراكز الحضرية وللتعلم، حيث المدارس والجامعات فيها والصحة والمستشفيات الكبرى للتطبيب، كذلك لإيجاد فرص العمل والحياة، وكان النظام الملكي لا يملك القدرات المالية والاقتصادية والموازنات للتوسع في الأقضية والنواحي الملاصقة للريف.
مشروع إزالة “الصرائف “
يقول مخطط المدن المعماري تغلب عبدالهادي الوائلي إن “مشروع إزالة الصرائف بدأ مطلع الخمسينيات، على يد مخططي مجلس الإعمار العراقي الذي أنشأه العهد الملكي، بهدف معالجة السكن العشوائي وبناء دور مناسبة للعراقيين الذين لا يملكون مساكن واضطروا إلى السكن في بغداد بعد انهيار الإقطاع، وزحف جيوش العاطلين المتطلعين للعيش إلى مراكز المدن، والتقرب من المدينة والتنعم بفضائلها وميزاتها في العيش والحداثة، وكانت المشكلة أكبر من إمكانات الدولة وقتها، جراء تفاقم الظاهرة وزيادة الأعداد المتدفقة على العاصمة من المناطق الجنوبية والوسطى”.
ويضيف “شرع مجلس الإعمار ببناء وحدات سكنية مناسبة شرق بغداد في الجهة الشرقية لقناة الجيش، وكانت بيوت مناسبة وحضارية بمعدل 200 متر مربع للبيت الواحد، لكن مع انقلاب الجيش على النظام الملكي وتولي الزعيم عبدالكريم قاسم الحكم، أراد الأخير أن يحقق منجزاً للفقراء بإزالة العشوائيات والصرائف من بغداد وتحويل سكنهم نحو شرق العاصمة (خلف السدة) فاضطر النظام العسكري إلى أن يعجل بتوزيع الأراضي وبناء وحدات سكنية، بمعدل 150 متراً مربعاً ثم تناقصت إلى 100 ثم 50 في أطراف المجمع السكني”.
الثورة (الصدر) المجتمع الموازي
مدينة الثورة (الصدر) تشكل مجتمعاً موازياً لمجتمع بغداد الحضاري، وتواجه تحديات حضرية معقدة ناتجة من عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية، استمرت على مدى 70 سنة، فأبرز المشكلات الحضرية يتمثل بالاكتظاظ السكاني ويقدر بـ4 ملايين نسمة، يرافقه نمو يفوق قدرة البنية التحتية، مما انتج انتشار مجتمع العشوائيات والمساكن غير النظامية لتضيف عبئاً على البنية التحتية المتدهورة، وهناك مشكلات متصلة أخرى، لاسيما شبكات الصرف الصحي القديمة والمتهالكة، مما يؤدي إلى فيضانات متكررة، إضافة إلى نقص الكهرباء والمياه الصالحة الشرب في مدينة ضيقة الطرق والمسالك غير المعبدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهناك تحديات ارتفاع معدلات البطالة والفقر، بخاصة بين الشباب، في اقتصاد غير منظم يعتمد على الباعة الجائلين والورش الصغيرة، أما حال الخدمات العامة فهي محدودة، كنقص المرافق الصحية والتعليمية، وتردي جودتها وسوء إدارة النفايات الصلبة، مما يزيد التلوث والأمراض في بيئة مكتظة.
أما التحديات الأمنية والاجتماعية فهي تتوالد مع الزمن، جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية وانتشار الجريمة المنظمة في بعض الأحياء، وأضاف التلوث البيئي وتلوث الهواء بسبب المولدات الكهربائية والعواصف الترابية، والتلوث جراء اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة أزمة أخرى غير مسيطر عليها.
مدينة قاصدي حلم بغداد
يقول الباحث والكاتب محمد الغزي إن “مدينة الصدر تمثل إشكالاً حضرياً واجتماعياً معقداً في العراق، فهي من أكبر التجمعات السكانية في بغداد، وبقيت حبيسة فقرها وتهميشها على رغم المشاريع المتكررة، فأزمتها في أن التمدد العمراني والخدمات لا يوازيهما تحول اجتماعي أو اقتصادي يجعلها مدينة منتجة بدلاً من كونها كتلة بشرية ضخمة تعيش على هامش الدولة”.
ويضيف “المدينة نشأت كمشروع إسكان للفقراء، ولا أحب هذه التسمية، لذلك أعدها مدينة للحالمين بالسكنى في بغداد، لكن توسعها لم يكن مدروساً وهذه أبرز إشكالاتها، مما يجعلها بيئة مكتظة وعشوائية في النمو، لا تزال ثقافة المدينة تتسم بالولاء للجماعات التقليدية، بدلاً من المؤسسات المدنية، مما يعقد أية محاولات للتحديث، فعلى سبيل المثال ترفض معظم المحال التجارية وضع حاويات النفايات أمامها، مما أجبر الجهة المنفذة لمشروع تطوير الشوارع والأرصفة إلى وضعها في الجزيرة الوسطية بصورة متخلفة ومعيقة لحركة السيارات، وهذا بالاتفاق مع المجلس البلدي، لذلك إذا بقيت الحلول محصورة في الإسكان من دون إصلاح جذري لمنظومة المجتمع والاقتصاد، فإن المدينة ستبقى بؤرة للفقر والتوتر، مهما تعددت مشاريعها”.
السلطات وراء “التريف”
ويذهب الكاتب الكردي كفاح محمود إلى بعد آخر لظاهرة المدن التي “تريفت” قسراً كمدينة بغداد جراء السلوك السلطوي، موضحاً أن “عملية تريف المدن وصلت إلى ذروتها عشية احتلال العراق، وسقوط نظامه السياسي، واختزال المواطنة إلى انتماء قروي أو عشائري، للحفاظ عن طبيعة النظام الجديد، مما أدى إلى تلك الهجمة البربرية على كل منشآت الدولة ومخازنها ودوائرها ومؤسساتها في أكبر عملية نهب وسلب وسرقة في وضح النهار وأمام عدسات الكاميرات وقوات الاحتلال، إضافة إلى مضاعفة الانتقال والهجرة من الأرياف والقرى إلى مراكز المدن وأطرافها”.
يقول محمود إن “هذا التريف الموجه وغير الموجه أحدث خللا كبيراً وخطراً في بنية المجتمعات العراقية ومناطق استيطانها وبالذات بعد سقوط النظام، حيث النزوح الكبير من القرى والبلدات الصغيرة إلى مراكز المدن ونشوء مجمعات كبيرة بنيت على أراضي مملوكة للدولة زراعياً، والتعامل معه لاحقاً كواقع حال وتمليك تلك المباني للمتجاوزين أو تعويضهم بمبالغ كبيرة”.
استراتيجيات شاملة
يقدم الباحث رؤيته للحلول الممكنة لهذه الأزمة، وذلك من خلال “تبني استراتيجيات شاملة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من القرى والأهوار، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتوفير مياه الشرب النظيفة والكهرباء، والصرف الصحي والمواصلات والمدارس، مما يعزز استقرار السكان في قراهم، كما أن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية يسهم في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الزراعة وصيد الأسماك من خلال تقديم دعم حكومي وتقني، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين والصيادين، كما يمكن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بهذه القطاعات، والترويج للسياحة البيئية في الأهوار”
يرى الكاتب والباحث جمال حسن العتابي أن “كل مشاريع البناء والمجمعات السكنية التي تمت وتنفذ حالياً في بغداد، هي مشاريع عشوائية، بإزالة عشوائيات مدن الصفيح والصرائف وإحلال عشوائيات جديدة حديثة بنيت بعيداً من التخطيط العمراني العلمي الصحيح، أي بمعنى أن هذه المجمعات لم تراع موضوع البنى التحتية المتهالكة المستهلكة لمدينة بغداد، على وجه التحديد، فمن الأولى إعادة النظر في الكهرباء ومجاري المياه وشبكة المياه الصافية والشوارع والأنفاق”.
ويضيف أن “ما جرى من مشاريع مجسرات بغداد سيعقد المشكلة حيث البناء بعيداً من مراعاة إصلاح أو تغيير البنى التحتية التي بحاجة إلى إصلاح تام لكل مدينة بغداد، وهذه المجمعات السكنية حول مطار بغداد، وفي مطار المثنى الذي تحول إلى مجمع سكني وامتد لحديقة الزوراء، تم على حساب تجريف وإزاحة بساتين النخيل تحديداً، في الوقت الذي نسمع فيه منذ عشرات السنين عن مشروع ’حزام بغداد الأخضر‘ الذي لم ينفذ، لكنهم أيضاً لم يحافظوا على المناطق الخضراء القائمة، التي تعد رئة العاصمة”.
ويعتقد العتابي أن تلك المشاريع تنفذ لصالح حفنة من رجال الأعمال المستفيدين أو من سماهم “أصحاب الثروات الجدد”، ويدلل على ذلك بـ”ارتفاع أسعار تلك المجمعات السكنية التي لا يتمكن منها ذوو الدخل المحدود، ولا أيضاً موظفو الدولة من الفئات المتوسطة وأبناء الطبقة الوسطى”.
اغتراب اجتماعي
الباحث في علم الاجتماع الثقافي أحمد حميد يرى أن “وجود هذا الكم البشري الهائل في مدينة الصدر (الثورة سابقاً)، ضاعف الحركة داخل العاصمة، وتمكن أبناء هذه المدينة من اقتناص جميع فرص العمل المتاحة، أينما كانت في بغداد، سواء أكان ذلك على مستوى القطاع العام أو الخاص أم عن طريق الكسب اليومي من خلال الحرف والأسواق العامة”.
يوضح حميد أنه “منذ سمحت الحكومة في منتصف القرن الماضي، بتوطين أبناء الجنوب الهاربين من سوط الإقطاع الزراعي، بمناطق شرق بغداد، يعاني مستوطنو العاصمة اغتراباً اجتماعياً مع السكان المتمدنين، الذين يرفضون التعاطي الإيجابي معهم، وذلك لجهة عدم اندماجهم في قيم وثقافة البغداديين، فضلاً عن تسويقهم للثقافة العشائرية التي ضربت ثقافة الاحتكام للقانون، لذا انقسم المجتمع في بغداد إلى ثقافتين، واحدة مدنية يمثلها سكان وسط العاصمة وملحقاتها، وثقافة عشائرية يمثلها الساكنون في مناطق الشرق منها”.
وأشار إلى أنه “دائماً ما تحدث معارك إعلامية، وتنابز مناطقي بين كلا المجتمعين، أحياناً تعززها محركات السلطة، فسلطة صدام حسين تحديداً، كانت تسعى إلى التحقير والنيل من أبناء الجنوب القاطنين في بغداد، وذلك بوصفهم بؤرة تنشط فيها الجماعات المعارضة للنظام، بدءاً من الشيوعيين وصولاً إلى الإسلاميين، والمتتبع للمسار الاجتماعي لمدينة الصدر (الثورة سابقاً)، يلاحظ أن هذه المدينة فيها من التضاد الرهيب والعجيب، إذ أنتجت كثيراً من المبدعين العراقيين، في مجالات الأدب والرياضة والصحافة والجامعة، وفي الوقت نفسه هم الخزان البشري للجماعات التي تستخدم العنف وسيلة في الحراك المجتمعي والسياسي في آن واحد، هناك انقسام ثقافي في بغداد، ثقافة عشائرية في شرق العاصمة، وثقافة مدنية في وسطها وما يدور حولها. وكلتا الثقافتين في صدام دائم حيال الحياة المدنية ومميزاتها التي تكاد تنعدم”.
قناة الجيش وأزمة الاندماج
فرضت القناة المائية المسماة بـ”قناة الجيش” فصلاً قسرياً بين مجتمع بغداد وعالم المدينة الأكبر في العاصمة العراقية بقناة مائية صناعية تم افتتاحها عام 1960 من الزعيم عبدالكريم قاسم، بعد أن حفرها الجيش بطول 23 كيلو متراً و350 متراً وعرضها في القاع ثلاثة أمتار، وعمقها متران، وتبدأ من شرق دجلة التي تسمى بصدر القناة متجهة نحو شرق بغداد ثم إلى جنوبها، إذ تصب في نهر ديالي وعليها سبعة جسور، والغرض من حفرها تصريف مياه الفيضان وتحويل المياه من غرب بغداد نحو شرقها حتى المصب في جسر ديالي نحو وسط وجنوب العراق، وكانت ضرورة قصوى لإنقاذ بغداد من الغرق بواسطة هذا المنفذ والممر المائي.
وكان أن عثر عبدالكريم قاسم على خرائط المهندس المعماري اليوناني قسطنطين دوكسياديس (1913-1975) الذي وضع التصميم الأساس لبغداد، ليجد ضالته في بناء مشروع شرق بغداد، ويشرع بفتح قناة الجيش بإمكانات محدودة ويبني مدينة الثورة لفقراء العراق بهدف وضع سقوف كونكريتية فوق رؤوسهم، ونال التفاف الفقراء حوله وترك (مدن الصرائف) المهلهلة وشرع الناس بمساعدة الجيش لبناء أكبر مدينة عمالية في البلاد، مما تسبب في أكبر القضايا الاجتماعية الإشكالية بعد أن هجر الفلاحون مزارعهم وحقولهم ولجأوا للعيش في بغداد وسرعان ما كبرت المدينة وصارت ضيقة على سكانها على رغم فصلها بالقناة التي تجعلها بمنأى عن مدنية العاصمة.
لكن القناة لم تعد فصلاً طبيعياً بين (الثورة) وسكان بيوت بغداد الكبيرة التي يقطنها موظفو الدولة وتجارها ومعالمها الحضرية، إذ أدرك كثير من المتخصصين في علم الاجتماع والسياسيين ومثقفو البلد بأن عزل المدينة ليس بصالح مدنية بغداد وأدركوا أن القناة الفاصلة بين مجتمعي بغداد هي العقدة، فقدم عدد من مخططي المدن العراقيين رؤية تصحيحية لتقليل الفجوة بين بغداد غرب القناة والأخرى شرق القناة، ومن بين أهم تلك المشاريع مخطط السندباد الذي قدمه المعمار تغلب الوائلي إلى مجلس الوزراء وقبلها لأمانة بغداد الذي يحول قناة الجيش إلى أكبر متنزه في بغداد، ويربط جانبي المدينة بسلسلة من الفعاليات الخدمية والفنية والثقافية وملاعب الأطفال ومدن الألعاب.
يمتد المشروع على مساحة 460 هكتار نحو (4.6000.00) متر مربع، على طول القناة وتشغل مساحة الطرق والمسطحات المائية 100 هكتار ومساحات استثمارية متبقية بمقدار 360 هكتاراً، يزيل خمول المنطقة ويحركها ويطورها حضرياً، لكن المشروع الطموح الذي شرعت به الأمانة ثم توقفت جراء عراقيل إدارية وشبه فساد كما أكد المعماري تغلب الوائلي، فظلت الحال على ما هي عليه، وظلت بغداد تعاني الفصل والانقسام والتباين الطبقي.
نقلاً عن : اندبندنت عربية