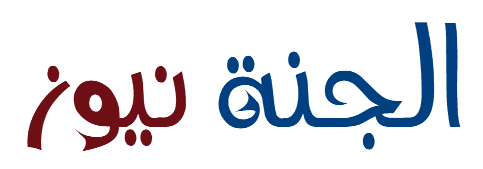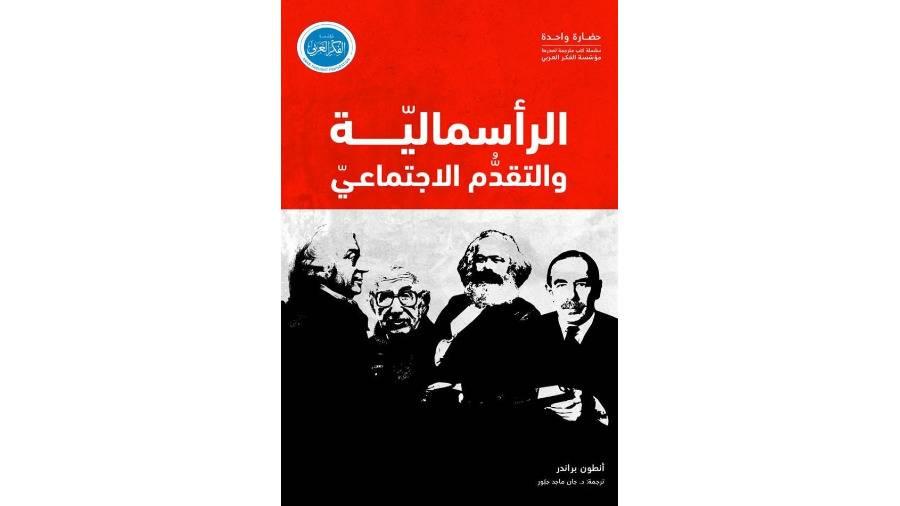
في أعقاب الحرب العالمية الثانية شهد الغرب تحسناً عميقاً في الظروف المعيشية، تشارك فيه الجميع على نطاق واسع، وذلك لأنهم إثر تاريخ طويل وصاخب، نجحوا في السيطرة على القوة الإنتاجية للرأسمالية، إلا أن تقدمهم السابق لا يجب أن يعزى إلى الرأسمالية نفسها، وإنما إلى المسار الذي سلكوه لكي يحققوا نجاحاتهم، فهم لم يسعوا إلى تدمير الرأسمالية، لكنهم لم يتركوا لها كذلك الحبل على الغارب.
من هنا نظمت القوى الاجتماعية نفسها لفرض القواعد والقيود عليها، ولممارسة ضغط على ارتفاع قيمة العمل، من دون هذه القوى ومن دون قدرتها على التعبير عن نفسها من خلال التمثيل الديمقراطي لم يكن لهذه المجتمعات أن تشهد مثل هذا التقدم.
يشير أنطون براندر في كتابه «الرأسمالية والتقدم الاجتماعي» (ترجمة د. جان ماجد جبور) إلى أن تلخيص تقدم المجتمع من خلال الإنتاج لكل ساعة عمل سيكون أمراً سخيفاً، فحصة الإنتاج التي يقوم بها كل فرد تعتبر حاسمة في تحديد ما إذا كانت الظروف المعيشية تتحسن ليس في المعدل الوسطي فحسب، ولكن أيضاً بشكل يشمل الجميع، فإذا تعذر أن يكون هذا التحسن موزعاً بشكل عادل فأقله أن يكون شاملاً وإلا فإن الحديث عن التقدم الاجتماعي لا معنى له.
*ازدهار
يوضح المؤلف أنه على الرغم من حجم التفاوتات الآخذة في الاتساع يصعب إنكار التحسن في السبعين عاماً فقط التي أعقبت الحرب العلمية الثانية، زاد الدخل قبل الضريبة للبالغين الأمريكيين في الشريحة العشرية الأعلى من توزيع الدخل مرتين أسرع من دخل نصف الشريحة الأقل أجراً بين السكان ولكن دخل الأخيرة هذه تضاعف مع ذلك.
يمكن إجراء الملاحظة نفسها على مؤشرات أخرى مثل متوسط العمر المتوقع، ففي جميع البلدان المتقدمة تقريباً لم يتوقف متوسط العمر المتوقع عن الزيادة لأكثر من قرن، حتى وإن لوحظت فروقات كبيرة داخل كل مجتمع، وبالتالي لا يزال هناك فرق كبير في فرنسا بين متوسط العمر المتوقع لعامل يبلغ من العمر 35 عاماً ومتوسط العمر المتوقع لشخص في سنه نفسه، يتبوأ منصباً إدارياً.
لن يكون هناك تأريخ للرأسمالية ولا سرد للنضالات الاجتماعية والصراعات السياسية التي دفعت بالرأسمالية لخدمة التقدم الاجتماعي، إن طموح هذا الكتاب هو وصف آليات التفاعل بين الرأسمالية والمجتمعات التي ازدهرت فيها، وتبيان السبب الذي جعل هذه الآليات التي كانت في أصل التقدم الاجتماعي تكبح في أيامنا الحاضرة، ومع ذلك فإن المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي سلكته هذه المجتمعات لم يكن من المفترض أن يحكم عليه بالفشل، فثمانينيات القرن الماضي شكلت انتصاراً للأيديولوجيا الليبرالية وفي مواجهة العولمة والتغيرات التقنية التي شقت طريقها في تلك الحقبة، كان من الضروري بذل جهد مضاعف لجعل المجتمعات الغربية تحافظ على توازن قوي ملائم مع الرأسمالية.
يرى الكتاب أنه بدءاً من السبعينيات في القرن العشرين أصبح هذا الاتساق بين الضغوط الاجتماعية والسياسات العامة وتنظيم الرأسمالية موضع شك بسبب ظاهرة جديدة: العولمة. في الواقع لم تكن العولمة أمراً جديداً بالنسبة إلى الرأسمالية. قبل الحرب العالمية الأولى كان يتم التداول برأس المال وبالسلع بحرية من بلد إلى آخر لكن هذا لا يعني أن الرأسمالية كانت معولمة، إذ إن التنافس بين القوى الأوروبية والأهمية الاقتصادية لمستعمراتها واللجوء المتكرر إلى الحمائية أسهمت في منح الدول الغربية رأسماليات وطنية للغاية.
*أضرار
يدعو الكتاب المجتمعات الغربية إلى أن توسع أفق سياستها فلا يمكنها الاستمرار في تجاهل التكاليف التي تتسبب بها الإضرار التي تلحق بالكوكب بفعل أسلوب التنمية الذي تتبعه، وإلقاء اللوم على الرأسمالية لن يكون منطقياً هنا كما في أي مجال آخر؛ ذلك أن الرأسمالية لا تهتم إلا بعالم السلع، وهنا تبرز الحاجة لرصد مبالغ مالية كبيرة لا سيما أن التحويلات والاستثمارات التي يجب تمويلها لا تتعلق بالبلدان المتقدمة فقط، ذلك أن بيئة الكوكب لا تعرف حدوداً، ولا يمكن إيقاف حركات الهجرة الناشئة عن طريق بناء الجدران.
المصدر : صحيفة الخليج