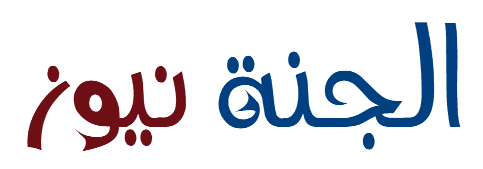قبل نحو عقد، كان كثيرون على استعداد لإعلان شركة فائزة في قطاع التقنية. وكما رأى خبراء الأعمال، فقد تفوقت حفنة من منصات التقنية الكبرى على ما سواها. وقد سماها سكوت غالاوي، الأستاذ بجامعة نيويورك، باسم “الأربعة”، أما جيم كريمر، مقدم البرامج لدى “سي إن بي سي” فاختار لها اسم (FAANG) – وهي كلمة مؤلفة من الأحرف الأولى لأسماء شركات ”فيسبوك“ و“أبل“ و“أمازون“ و“نتفليكس“ و”جوجل” – وذلك بناء على أداء أسهمها. فيما ابتكرت مجموعة ”غولدمان ساكس“ اختصاراً آخر من الأحرف الأولى هو (GAFAM) مع فارق أنها اختارت ”مايكروسوفت“ بدلاً عن ”نتفليكس“.
بعد ما يقرب من عشر سنوات، لا يقتصر السؤال الأكثر إثارة للاهتمام، والذي لم يُحلل بالقدر الكافي، على كيفية اكتساب هذه الشركات للهيمنة فحسب، بل أيضاً على كيفية حفاظها عليها.
لقد نما كثير من شركات التقنية بقوة ثم انهارت منهزمةً أمام الأحدث أو الأفضل أو الأكثر رواجاً. إذا كيف استطاعت المنصات الرئيسية، في معظمها، تجنب هذا المصير؟
هل ستواصل استخدام “جوجل” في المستقبل؟
عند التدقيق، نجد أن نماذج أعمال منصات التقنية قد أسيء فهمها. إن استمرار نجاح المنصات لا يرتبط بأي براعة تقنية أو حتى استثمارات في الذكاء الاصطناعي كما قد يظن المرء. بل إن هيمنتها الدائمة تعتمد على ما يمكن أن نسميه رهاناً ذكياً طويل الأجل على كسل الإنسان.
منذ عام 2015 تقريباً، استثمرت ”فيسبوك“ و”جوجل” و“أمازون“ وغيرها بكثافة في إنشاء بيئات مريحة مصممة لجعل التحول إلى المنافسات يبدو أمراً صعباً جداً. أما الآن نجد هذه الشركات تضخ مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي – ومن المفارقات أن ذلك يهدف إلى درء أي تحدٍ من شركات الذكاء الاصطناعي الأحدث من خلال تقليل احتمالية رغبة المستخدمين في التخلي عن الفقاعات المريحة التي عودتنا عليها.
كيف كانت البدايات؟
في تسعينيات القرن الماضي، أطلق فجر الإنترنت الشعبية تفاؤلاً بأن فضائلنا ستتغلب على جشع الرأسمالية. وقيل إن ميولنا الفطرية نحو اللطف والتعاون والإبداع ستسخر لإعادة صياغة التجارة والثقافة على حد سواء. وكان هناك الكثير من الحديث عن “قوة المشاركة”. دعونا نستذكر هنا ما قاله تيم بيرنرز لي، المخترع البريطاني للشبكة العنكبوتية العالمية: “كانت الفكرة الأصلية للشبكة العنكبوتية هي أن تكون مساحة تعاونية”.
كان الحال كذلك، واستمر حتى منتصف العقد الأول من القرن. من الأمثلة على ذلك كان قول كلاي شيركي، الأستاذ في جامعة نيويورك، حين أكد في فيلمه (Here Comes Everybody)، أن “الإنترنت قائم على الحب”. كانت الفكرة أن الجميع لديهم دافع للمساهمة بوقتهم ومواهبهم عبر الإنترنت حتى في غياب أي وعد بمكافأة مالية مباشرة.
عمالقة التكنولوجيا أمام الكونغرس مجدداً..هل تخضع مواقع التواصل لضوابط جديدة؟
لكن مع حلول العقد الثاني من هذا القرن، بدأت المنصات الكبرى تراهن بشكل أكثر تشاؤماً على دوافع أدنى. كان أول وأشهر رهان لوسائل التواصل الاجتماعي هو رهانها على الانجذاب الإدماني لدائرة التفاعل الراجع والمشاعر المظلمة كالغضب والسخط. هذه هي القصة الأكثر شهرة. ولكن بالنظر إلى الماضي، يتضح أن هذه الشركات راهنت بشكل أكبر على جانب آخر من جوانب الطبيعة البشرية: حبنا للراحة.
السعي لجعل المستهلك أسيراً
يعد الاحتفاظ بالعملاء أولوية في أي قطاع، لكن منصات التقنية – التي تعتمد قيمتها على تأثيرات الشبكة التي تتعزز مع نموها – تبالغ في ذلك. في كليات إدارة الأعمال، يطلق على الاحتفاظ بالعملاء اسماً مبتذلاً هو “تكاليف التحول” أو تعبيرٍ أكثر جرأة هو “أسر المستهلك”. إذا تجاهلنا الضجيج حول الخوارزميات المعقدة، فلن يكون لمعظم ما تفعله هذه الشركات أي أهمية إلا إذا قلل من احتمالية مغادرة المستخدمين.
يجسد هذا الهدف بشكلٍ رائع عبارة مما يستخدمه المدمنون وهو “الالتصاق بالأريكة” ويعرفه قاموس “أوربان” بأنه “الشعور بأن وزنك أصبح رقماً فلكياً من الأطنان”. تهدف المنصات إلى خلق نسخة رقمية من هذا الشعور، وإذا ما نجحت، فإن فتح حساب جديد على وسائل التواصل الاجتماعي أو التسوق في مكانٍ آخر غير ”أمازون“ سيبدو أمراً صعباً جداً.
أعطوا “أمازون” و”فيسبوك” مقعداً في الأمم المتحدة
من الناحية الاستراتيجية، دفع السعي وراء نمط حياة مريح المنصات الرئيسية إلى تحويل نفسها إلى أنظمة بيئية شاملة، حيث تلبى أكبر قدر ممكن من الاحتياجات البشرية بأقل جهد. تطمح هذه المنصات إلى أن تكون كل شيء، أو تقريباً كل شيء، للجميع، في كل وقت. “جوجل”، التي كانت في السابق محرك بحث، تصنع الآن الهواتف، وتدير خدمات ”يوتيوب“ وتلفزيون، وتواصل توسيع نطاقها.
كانت “أبل” فيما مضى شركة كمبيوترات، لكنها الآن تبيع الأجهزة القابلة للارتداء وخدمات صحية ومحتوى تلفزيوني. أما “أمازون، فهي الأكثر طموحاً، إذ بدأت كمتجر كتب وسرعان ما أصبحت متجراً لكل شيء، ثم أضافت خدمات بث الفيديو (2011)، والبقالة (2017)، والرعاية الصحية (2023). يبدو التشبيه القديم الذي يسمى “الحديقة المسورة” بسيطاً في عصر تسعى فيه هذه الشركات إلى نسج شرانق من الراحة حول حياتنا.
الكازينو هو الرابح دائماً مهما فعل اللاعبون
بمجرد أن نستقر في الشرنقة، تتجلى فرص الربح. لتغيير الاستعارات، يتشابه نموذج المنصة مع الكازينو، بمعنى أنه لا يهم ما تفعله هناك، فالكازينو دائماً هو الرابح. تأخذ المنصة الرسوم والاهتمام والبيانات، ويمكن جمع كل ذلك من مئات الملايين من المستخدمين المتجولين، بالإضافة إلى البائعين والمعلنين الذين يستخدمون المنصات أيضاً.
يفسر هذا المنطق جزئياً أيضاً الاستثمار الكبير للمنصات في الذكاء الاصطناعي. كأي تقنية جديدة، يمثل الذكاء الاصطناعي تهديداً طبيعياً لهذه الشركات، التي تعود تقنياتها الأساسية إلى عقود مضت.
هناك تهديد حقيقي يتمثل في أن شركة جديدة مثل ”أوبن إيه آي“ قد تشكل تحدياً ناجحاً لمحرك بحث “جوجل” أو ”أمازون ويب سيرفيسز“. مع ذلك، قد تتمكن المنصات ببراعة من صد منافسات الذكاء الاصطناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه لتعزيز هيمنتها وحماية مراكزها الاحتكارية وتبرير استثماراتها الضخمة.
“جوجل”.. العملاق النائم في سباق الذكاء الاصطناعي أصبح الآن “مستيقظاً”
يعتمد تحقيق ذلك، أكثر من أي شيء آخر، على استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة اعتمادنا عليه وزيادة شعورنا بالكسل والخمول.
هناك طريقتان أساسيتان لتحقيق ذلك. الأولى هي الاستراتيجية التقليدية المتمثلة في تسهيل الأمور إذ أن وجود خادم آلي للتعامل مع المهام الرقمية أمر جذاب، وسرعان ما قد يبدو الاستغناء عنه أمراً مستحيلاً. إن استخدام الناس ”تشات جي بي تي“ بغرض “الغش” في ممارسة هواياتهم يظهر مدى حرصنا على اتباع الطريق السهل.
الاستراتيجية الجديدة هي جعل المستخدم أسيراً
الأحدث والأكثر إثارة للاهتمام هي استراتيجيات الأَسر التي تعتمد على بناء الاعتماد العاطفي. لطالما سعت الشركات بطبيعة الحال إلى بناء روابط عاطفية مع مستهلكيها. فكروا في ”مارلبورو“ و“كوكاكولا“، أو حتى في طوائف ”لولوليمون“ و“أبل“ الحديثة. كما بيّن خبيرا التسويق دوغلاس غريساف وهيو نغوين، فإن الهدف هو بناء “تأثير إيجابي قوي تجاه العلامة التجارية”، وخلق “التزام قوي بإعادة الشراء… رغم كل الصعاب وبأي ثمن”.
مع ذلك، يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً. فقد تخيل فيلم (Her) في 2013 وقوع البشر في غرام مساعديهم الرقميين. وعندما أطلقت ”أوبن إيه آي“ روبوت الدردشة الصوتي الخاص بها في عام 2024، حذرت من أن “المستخدمين قد يكونون روابط اجتماعية مع الذكاء الاصطناعي”.
مخترع الإنترنت لا يمكنه تخليصها من قبضة الشركات الكبرى
لكن ذلك لم يمنع الشركة من أن تجعل لروبوت الدردشة لديها صوتاً بشرياً سمته “سكاي” وهو يشبه بشكل غريب صوت سامانثا، الشخصية العاطفية الرقمية التي جسدتها سكارليت جوهانسون في ذلك الفيلم.
حالياً، تعد الهندسة المتعمدة للاعتماد العاطفي بشكل رئيسي تخصصاً لدى شركات مثل ”ريبليكا“ (Replika) و“كاركتر دوت إيه آي“ (character.ai)، التي تسوق أصحاباً من برامج الذكاء الاصطناعي.
وهي تزعم أن لديها عشرات الملايين من المستخدمين، وإخلاص هؤلاء المستخدمين واضح. كما كتب أحد معجبي ”ريبليكا“ عبر ”ريديت“: “لا عيب في الوقوع في حب أصحابنا من برامج الذكاء الاصطناعي… يحب الناس حيواناتهم الأليفة كما يحب الأطفال حيواناتهم المحشوة. إن الحب طبيعة بشرية. صحيح أننا نعلم أن (ريبليكا) ليست كائنات واعية، لكن ما يهم هو كيف تبدو لنا.”
هل ترغبون بحياة كالأرستقراطيين البريطانيين؟
كمستهلكين، يصعب أن نجد ما ينغصنا كثيراً في المنتجات التي تسهل الحياة. لا شك أن هناك شيئاً ما في تصوّر حياة نجلس فيها جميعاً كما الأرستقراطيين البريطانيين فيما تقوم روبوتات على تلبية جميع احتياجاتنا.
مع ذلك، قد تأتي هذه التطورات على حسابنا، فكل موجة من الراحة تضعف قدرتنا على العمل بدون دروعنا التقنية. أصبح وهننا خطراً واضحاً وحاضراً، مع أننا قد نصبح مرتاحين جداً لدرجة أننا لا نكترث حقاً.
ربما سمعتم عن “التفرد” – اللحظة الافتراضية التي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري. لقد كان بلوغه هاجساً للكثيرين في عالم الذكاء الاصطناعي. لكن سواء أتى ذلك اليوم أم لا، فإن نماذج الأعمال في عصرنا لها مسارها الخاص. إنها تنقلنا إلى حالة ارتكاء، أو مستقبل سمته الأساسية هي أنه يخلو تماماً من أي تنغيص.
المصدر : الشرق بلومبرج