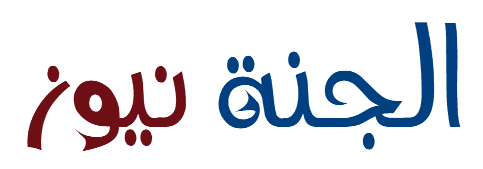لم يكن تجليد الكتب المدرسية في الماضي مجرد عملية لحماية الأوراق من التلف، بل ارتبط بذاكرة جماعية صنعت أجواءً خاصة في البيوت العربية مع بداية كل عام دراسي.
كانت رائحة الورق الجديد والنايلون المخصص للتغليف أشبه بإشارة صامتة تعلن نهاية العطلة الصيفية وبداية مرحلة جديدة من الانضباط والالتزام، حيث تتحول الطاولة أو سجادة المنزل إلى ورشة صغيرة يجتمع حولها الأطفال والأهل، ويتنقل المقص والشريط اللاصق من يد إلى أخرى، وسط ضحكات ونقاشات لا تنقطع.
ومع أن الخيارات في الألوان كانت محدودة بين الشفاف والأزرق، فإن عملية التغليف شكلت لحظة فارقة، تمنح الكتب مظهراً أنيقاً يعكس شخصية الطالب وحرصه على النظام، عندما كانت الأغلفة أشبه ببطاقة هوية، يكتب عليها الاسم بخط مرتب، وتتحول إلى أول انطباع يحمله المعلم أو الزملاء عن صاحبها.
رحلة عبر التاريخ من الربط القبطي إلى النايلون
يمتد تاريخ التجليد إلى القرون الأولى للميلاد حين ابتكر الرهبان الأقباط في مصر أسلوب الربط القبطي باستخدام الخيوط المتينة لجمع الملازم، بهدف حماية النصوص المقدسة من التلف.
ولاحقاً تطورت التقنيات لتشمل الجلد والرق والورق والقماش، وصولاً إلى التجليد الصناعي في القرن التاسع عشر مع ابتكار الأميركي ديفيد سمايث آلات خياطة الكتب، التي جعلت العملية أسرع وأرخص.
أما أول غلاف واق خارجي موثق فقد ظهر في بريطانيا عام 1829، وكان في البداية مجرد حماية مؤقتة، ثم تحول إلى عنصر تسويقي بصري، قبل أن يجد طريقه إلى المدارس كعادة سنوية مع ظهور الأفلام اللاصقة في منتصف القرن العشرين، ومع دخول البلاستيك إلى البيوت تحولت عملية التجليد إلى طقس متكرر، حيث يلتصق الغلاف بالكتب لتبدأ معها ذكريات الفقاعات الصغيرة التي كانت تتحول إلى لعبة بين الأطفال.
بين الحماية والترشيد وإعادة الاستخدام
لم يكن الهدف من تغليف الكتب جمالياً فقط، بل كان يرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية واضحة، ففي مدارس عربية عدة، مثل الأردن والسعودية والبحرين، ارتبطت العادة بسياسات رسمية لإعادة استخدام الكتب وترشيد الإنفاق. ففي الأردن أصدرت وزارة التربية عام 2022 تعليمات بإعادة توزيع كتب الصفوف العليا، ما جعل حماية الكتاب من التمزق والرطوبة ضرورة عملية. في السعودية صدرت تعاميم متكررة تشدد على تسليم الكتب بحالة جيدة بعد انتهاء العام، فيما نظمت البحرين آليات لتوزيع واستلام الكتب ضمن جداول رسمية.
وهذا البعد العملي جعل من التجليد وسيلة للحفاظ على الموارد وتقليل الهدر، إلى جانب دوره البيئي في الحد من إتلاف الكتب الورقية. وهكذا، كان الغلاف البلاستيكي أو الورقي أكثر من مجرد طبقة خارجية، بل ضمانة لاستمرار حياة الكتاب بين أجيال متعاقبة من التلاميذ.
ذكريات شخصية ومواقف لا تُنسى
ارتبط التجليد بذكريات فردية صنعت نكهة خاصة لكل طالب. بعضهم يتذكر جلسات العائلة التي تتحول إلى ورشة عمل يشارك فيها الجميع، فيما لا تزال رائحة الورق الجديد عالقة في الذاكرة كلما عاد الحديث عن بداية العام الدراسي. يروي البعض مواقف طريفة، مثل استخدام أكياس الخبز القديمة لتغليف الكتب، الأمر الذي أثار سخرية المعلمين والتلاميذ، أو نسيان أدوات صغيرة مثل المسطرة داخل الغلاف أثناء عملية التجليد، ما يؤدي إلى تمزيق الصفحات وإعادة العمل من جديد. آخرون يستعيدون لحظات شد الغلاف بالمسطرة للحصول على مظهر مستقيم، أو اختيار الألوان الزاهية والملصقات المزينة التي تضيف طابعاً شخصياً للكتاب.
وحتى الفقاعات الهوائية التي كانت تظهر تحت الغلاف لم تكن مصدر انزعاج، بل لعبة صغيرة يستمتع بها الأطفال. هذه التفاصيل اليومية صنعت ذاكرة جماعية تحضر اليوم بجرعة من الحنين، على الرغم من أن كثيراً من الأهل باتوا يلجأون إلى المكتبات التي توفر خدمة التجليد الآلي في دقائق معدودة.
الحنين في زمن الكتب الرقمية
مع تغير شكل التعليم وانتشار الأجهزة اللوحية والوسائل الرقمية، تراجع حضور الكتاب الورقي في حياة الطلاب، وبالتالي خفتت طقوس التجليد التي كانت تميز بداية كل خريف، غير أن كثيرين يرون فيها اليوم رمزاً لمرحلة مضت، وذاكرة لا تزال تعود مع رائحة الورق ورؤية الغلاف المشدود بإتقان.
وبعض الأمهات يصررن على تغليف دفاتر أطفالهن رغم اعتماد المدارس على الوسائل الحديثة، كنوع من إعادة إحياء طقس ارتبط بطفولتهن، وفي المقابل، يرى آخرون أن التجليد كان أكثر من عادة مدرسية، بل جزءاً من ثقافة احترام الكتاب باعتباره وسيلة للمعرفة تستحق العناية. وبين الورق والبلاستيك والقماش المطاطي، ظل الغلاف علامة على بداية رحلة جديدة في كل عام دراسي. ومع أن سحر تلك الطقوس لم يعد كما كان، فإن التجليد بقي شاهداً على علاقة حميمة جمعت بين الطالب وكتابه، وبين العائلة والمدرسة، في مشهد يصعب على الأجيال الرقمية أن تختبره بالطريقة نفسها.
المصدر : تحيا مصر