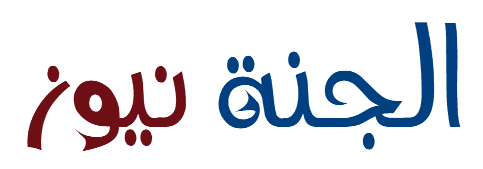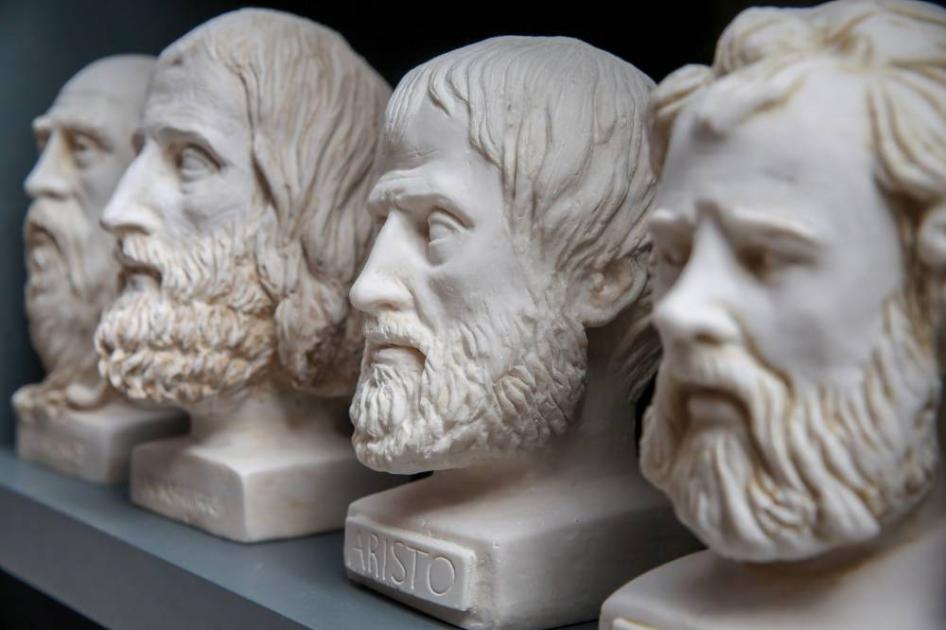
يشكو الكثير من الناس بمختلف خلفياتهم المعرفية والفكرية من نخبوية الفلسفة وما تحمل من أفكار ومفاهيم مجردة يصعب فهمها أو تفسيرها، لكن حب التفلسف والتفكير الفلسفي دائماً ما كان دافعاً للعديد من البشر في الاقتراب من هذا الحقل الذي يلفه الغموض وصنع علاقة معه، لأن فهم حقائق الحياة والوجود يتطلب التأمل والتفكير العميق وذلك تماماً ما تعنيه الفلسفة ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟، فقد حاول عدد من المفكرين تأليف كتب لتسهيل تلك العملية لكنها في ما يبدو قد زادت الأمر تعقيداً، وظلت قضية اقتحام عقبات الفلسفة أمراً بعيد المنال.
غير أن من أكثر الأشياء التي جعلت الفلسفة مهضومة للجميع هي لحظة التقائها بالأدب، ومن ثمّ كان المسرح هو أكثر الفنون التي أسهمت في انتشار الأفكار الفلسفية بطرق مختلفة عبر التراجيديا والمأساة وكذلك من خلال الكوميديا والعروض الواقعية، ثم كانت الفتوحات الكبيرة في هذا المجال مع ظهور وتطور فن الرواية والسرد بصورة عامة، ولعل ما يميز السرد عن المسرح في هذا المجال أن الأخير هو أيضاً فن نخبوي بشكل عام كما الفلسفة، بعكس الإبداع السردي الذي ربما يفهمه الجميع وله جمهور واسع، وصارت النصوص السردية تحتضن الأفكار الفلسفية بما في ذلك حكايات وروايات الأطفال واليافعين، حيث ظلت تحمل أسئلة الوجود والطبيعة والإنسان والكون ذلك المجهول، وصار السرد مجالاً جيداً ووسيطاً فعالاً في تمثل المفاهيم الفلسفية المختلفة والتعبير عنها، وتشير الكاتبة والفيلسوفة والأكاديمية أيريس مردوخ وهي من أشهر المنظّرين في هذا الإطار، إلى أن الأدب يمكن أن يقرأ من قبل الكثيرين ذوي مشارب ومنازع شتّى، أمّا الفلسفة فلا تُقرأ إلّا من قبل نخبة قليلة إذا ما قورنت بقرّاء الأدب، ومن هنا إمكانيّة وصول الفلسفة إلى أكبر شريحة من الناس عبر الرواية.
جسر
لكن من الخلل أن نظن أن الأعمال السردية التي استندت إلى فكرة التفلسف والمنطق هي محاولات لتبسيط الفلسفة، بقدر ما أنها كانت بمثابة جسر بين عالمين، ولحظة ولوج نحو مجاهيل الحياة وظلماتها بضوء الفلسفة، حيث جعلت الروايات والقصص والحكايات من المفاهيم التي تتسم بالتجريد كائنات حية تتجول حرة طليقة في فضاء الواقع مما يثريها ويزيد من فكرة التعاطي معها، ولعل من أبرز النصوص التي تمثلت هذه فكرة الرواية الخالدة «أليس في بلاد العجائب»، للكاتب الإنجليزي لويس كارول، والتي جمعت بين السرد الروائي والعديد من الأفكار الفلسفية التي تتناول المنطق والواقع والخيال والفوضى والعلاقات الاجتماعية، مما جعلها قصة تلقى قبولاً لدى الأطفال والبالغين والكبار على حدٍّ سواء، فقد حملت العديد من الرؤى والرسائل الفلسفية وركزت على لعبة المنطق والتناقضات والمفارقات الوجودية والحياتية وكذلك على مستوى البشر في لعبة سردية مراوغة ومتقنة، مما جعل قراءة الرواية تحظى بنوع من التسلية والمتعة التي تفتقر إليها، حيث بدأ الأمر وكأن «أليس»، وهي الراوية نفسها تتجول في أرض العجائب والتي هي الفلسفة بكل ما تحمل من الغموض والمعاني والدلالات المبهمة التي يتطلب الوصول إليها سعي قريب من رحلة «أليس» تلك.
تعدد
لذلك تعددت الأغراض والمواضيع الفلسفية في الرواية وتنوعت طرق تعامل السرد مع الفكر، فهناك العمل السردي الذي عبر عن لحظة إشراق فكري معين من خلال التأمل في الوجود وطرح الأسئلة المتعقلة بالإنسان، وهناك الأعمال التي تتناول موضوعاً فلسفياً متكاملاً بكل ما يتضمن من مفاهيم ومصطلحات، بل إن هناك من الفلاسفة من عمل على توصيل أفكاره من خلال الكتابة السردية والشذرية بعيداً عن معايير التأليف الفلسفي ولعل المثل الأسطع في ذلك الفيلسوف الألماني نيتشه في كتابه «هكذا تحدث زرادشت»، الذي جمع بين السرد الروائي والشعر والفلسفة في قالب ملحمي ليعرض أفكار الفيلسوف عبر شخصية زرادشت، حيث يصف البعض هذا الكتاب رواية فلسفية تتكون من سلسلة مقالات وخطب وشخصيات، مما يعطيه طابعاً روائياً مميزاً، وظهر بالتالي العديد من الروائيين الذين أبدعوا في هذا المجال وصنعوا نصوصاً تشهد على فكرة اللقاء المبدع بين حقلي الأدب والفكر.
وهناك أعمال أدبية تحمل الطابع الفلسفي صدرت من كتّاب يستندون في الأصل إلى مفاهيم ورؤى فلسفية خاصة به، وفي هذا السياق فإن الكثير من روايات فرانز كافكا، تعد أعمالاً سردية تعالج مواضيع فلسفية وجودية بامتياز كالاغتراب، العزلة، العبث، والبيروقراطية الظالمة، مستخدمة رموزاً ورؤى سريالية لاستكشاف حالة الإنسان في مواجهة عالم قاسٍ وغير مفهوم. من أبرز أعماله الفلسفية روايات مثل «المحاكمة» التي تستكشف الشعور بالذنب في مجتمع غير عادل، و«المسخ» التي تصور التحول الجسدي كرمز للضياع والفردية المنفصلة، وفي هذا السياق يعتبر نيكوس كازانتزاكيس أحد كبار الروائيين الذين لم ينفصلوا عن المشكلات الفلسفية، وهذا يعود إلى تكوينه الفلسفي على يد كل من برجسون ونيتشه، حيث تحضر كبرى المشكلات الفلسفية في رواياته، مثل الأنطولوجيا، ومسألة حقيقة الإنسان، ويلاحظ اهتمام الاتجاهات الحديثة في الأدب والفلسفة به كثيراً.
تجارب
من ضمن التجارب الكبيرة في تحشيد النص الروائي بمضامين وأسئلة فلسفية خالصة، تبرز تجربة الكاتب هيرمان هيسه في تناوله لمواضيع تنتمي للفكر البوذي وفلسفات الشرق، وكذلك باولو كويللو، خاصة في تركيزه على النزعة الروحية ومصير الإنسان، وكذلك أمبرتو إيكو الذي يقدم غوصاً وتنقيباً في فلسفات العصور الوسطى، خاصة في رائعته «اسم الوردة»، وأيضاً «ميلان كونديرا»، في نقده الفلسفي للشموليات، حيث تحمل تلك التجارب مشاهد ولفتات عميقة في الموقف من الحياة والوجود والتعبير عنها روائياً بأساليب تحتفي بالمعني والفكر وتراعي في ذات الوقت البعد الجمالي، وفي هذا الصدد يرى ألبير كامو أن الروائيين العظام هم الذين جمعوا بين الأدب والفلسفة مثل: بلزاك، ومليفيل، وستندال، ودوستويفسكي، وبروست، ومالرو، وكافكا
ترويج
نلاحظ أن هناك العديد من الكتاب الذين عملوا على الترويج لأفكارهم الفلسفية عبر الروايات مثل البير كامو الذي تتمحور رؤيته التي تسربت إلى أعمال مثل «الغريب»، حول مفهوم العبث الذي ينبع من التناقض بين رغبة الإنسان العقلانية في إيجاد معنى للوجود، وصمت الكون وغياب هذا المعنى. يرى كامو أن هذه المفارقة لا تؤدي إلى اليأس أو الانتحار، بل إلى التمرد الواعي على هذا العبث، وهناك أيضاً تجربة جان بول سارتر وسيمون دي بفوار إلى جانب كامو نفسه في تمثل الفلسفة الوجودية والترويج لها من خلال الكتابات السردية، ويأتي في هذا السياق كذلك الروائي الروسي مكسيم غوركي في التعريف بالفكر الاشتراكي وتبسيطه من خلال رواية «الأم»، كما أن هناك بعض المؤلفات الفلسفية التي كان موضوعها الفلاسفة أنفسهم وأفكارهم وتعاملهم مع الواقع اليومي مثل تلك السلسلة البديعة للكاتب والمحلل النفسي إرفين يالوم، حيث استطاع من خلال أعماله طرح أفكار أبرز الفلاسفة في العالم الغربي الحديث، في رواياته: «حين بكى نيتشه»، و«علاج شوبنهاور»، و«مأزق سبينوزا».
فارس بين حقلين
ولعل من أبرز الأسماء الكبيرة التي اقتحمت مجال الكتابة السردية الفلسفية، الروسي دوستويفسكي، الذي يبرز كفارس يتجول بين مضمارين، حيث تعرف رواياته بكونها أعمالاً فلسفية عميقة، حيث يطرح فيها أفكاراً حول الطبيعة البشرية والوجود الإنساني من خلال شخصيات تعاني صراعات نفسية وفكرية معقدة، خاصة في «الجريمة والعقاب»، «الإخوة كارامازوف».
إبداع عربي
في العالم العربي هناك العديد من التجارب في الكتابة الأدبية الفلسفية أو المتفلسفة، وربما من أبرزها أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي لا تغيب عنها التأملات الروحية والوجودية في مسار يجمع بين الواقعية والرمزية وتميل نحو العبثية في بعض الأحيان، ويتجلى ذلك في العديد من الأعمال مثل: «اللص والكلاب»، و«أولاد حارتنا»، و«ثرثرة فوق النيل»، والعديد من الروائع، ورغم وجود بعض الأسماء الأخرى لكن تجربة محفوظ تظل حالة خاصة في الإبداع العربي.
الفكـــر.. بوصلـــة الأدب فـــي عالـــم مضطـــرب
العديد من الكتاب الذين تحدثوا إلى «الخليج»، أشاروا إلى أهمية أن تحمل الكتابات السردية من قصة ورواية مضامين ومعاني فكرية، ولابد من اقتحام عالم الفلسفة المحصن بالغموض واللغة العالية، ويبدو هذا الأمر أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن حيث تبرز العديد من المفاهيم الفلسفية التي تحتاج إلى تناول موضوعات الاغتراب والاستلاب والفردانية وغير ذلك، وأشاروا إلى تجارب استطاعت بالفعل أن تصنع نوعاً من التزاوج بين عالمي الأدب والفلسفة. «الرواية هي ابنة الفكر، خرجت من معطف الفلسفة»، بتلك الكلمات تحدث الروائي علي أبو الريش عن العلاقة بين حقلي الأدب والفلسفة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للرواية والسرد هو إعادة صياغة العالم، وهو المجال الذي تشتغل عليه الفلسفة، وليس عكس الواقع كما يدعي بعض النقاد والكتاب، فالرواية تسعى إلى خلق شيء جديد ورؤى وآفاق جديدة لذلك هي بحاجة إلى الفكر.
وذكر أبو الريش أن الروايات والسرد عموماً يصنعان الأمل في نفس الإنسان، بما في ذلك الأعمال التراجيدية القاتمة والمظلمة، فبقدر ما هي تصف الواقع، فهي تعمل في ذات الوقت على إيجاد طاقة من النور والأمل، خاصة في واقع اليوم حيث يفتقد العالم للمعنى ويعم الفراغ الوجودي كما يؤكد ذلك الناقد والفيلسوف رولان بارت.
وشدد أبو الريش على أن أي كاتب سواء كان روائياً أو قصصياً لا يمتلك خلفية فلسفية فهو لا يستطيع أن ينتج أعمالاً ونصوصاً إبداعية حقيقية، فلابد للمؤلف الأدبي أن يتحلى بالثقافة الفلسفية ومعرفة المصطلحات والمفاهيم وأن يمتلك نظرة ورؤية خاصة تجاه الواقع والوجود، فالرواية لا تغير العالم لكنها تعيد إنتاجه وصياغته، بالتالي فإن الروائي هو نفسه فيلسوف. ولفت أبو الريش إلى أن الكتابة اليوم صارت في كثير من الحالات مجرد رقص على الحبال، لا تقدم شيئاً جديداً، هي للتسلية فقط، لا تحمل الأسئلة ولا المفاهيم ولا الرؤى والخلق والإبداع ولا التأمل في الوجود.
وأكد أبو الريش أن تجربته الروائية كانت شديدة التأثر بالفكر لأنه في الأصل متخصص في الفلسفة والتي تعد نافذة مهمة لانطلاق الأعمال الروائية، حيث إن الحياة نفسها عبارة عن سؤال فلسفي.
وأشار أبو الريش إلى أن هناك العديد من الكتاب العرب الذين حملت أعمالهم رؤى فلسفية ووفروا مساحات للسؤال من أمثال نجيب محفوظ والطيب صالح، وكذلك إبراهيم الكوني الذي قدم رؤية فلسفية في رواياته العميقة بثيمة الصحراء وعلاقتها بالإنسان، وهناك أيضاً الطاهر وطار والعديد من الكتاب الذين قدموا إبداعاً يحترم العقل ويتسم بالعمق.
ارتقاء
«لابد من أن ترتقي الكتابة نحو حدود أعلى من المعتاد بما يحترم عقل القارئ»، هكذا تحدث القاص إبراهيم مبارك، والذي أشار إلى أن الفلسفة عالم يحتشد بالغموض وجمهورها دائماً من النخبة، بالتالي فإن الكاتب الذي يتجه نحو مواضيع فلسفية لابد من أن يكون صاحب اتجاه أو موقف فكري يريد التعبير عنه أو هو بالضرورة مثقف استطاع تمثل وهضم المفاهيم والمصطلحات، ويستطيع بالتالي تحويلها إلى عمل روائي وقصص بشروط السرد، وتلك مهمة تبدو صعبة لكن هناك العديد من الكتاب الذين أبدعوا في هذا المجال على رأسهم دوستويفسكي وكافكا وغيرهما.
وأكد مبارك أن تضمين الأعمال السردية بالرؤى الفكرية والفلسفية هو إشراك للقارئ في النقاشات حول قضايا الوجود والإنسان وغير ذلك، حيث تخلق مثل هذه الكتابات نوعاً من النقاش حولها من قبل المتلقي كما أنها تحرض على التفكير والتأمل وتحفز الخيال، كما أنها كتابة تحترم القارئ وتحصن الأدب من الوقوع في الابتذال على نحو ما يحدث في العديد من الأعمال الأدبية هذه الأيام.
ونوه مبارك إلى أن الأدب استعار الكثير من الأساليب التقنية الفلسفية وهو الذي أدى إلى تطوره، حيث نجد أن توظيف الرمزية والتيارات العبثية واللامعقول هو ناتج عن لحظة تأثر الإبداع الأدبي بالفكر والفلسفة، وفي العالم العربي كذلك هناك العديد من الروايات التي نجد فيها قبس التفكير الفلسفي على نحو ما نجد في أعمال نجيب محفوظ وكذلك جمال الغيطاني حيث تتسم كتاباته بالعمق الفلسفي والتركيز على القضايا الكبرى مثل الحرية، العدالة، والقهر، ويطرح أسئلة فلسفية كبرى بين ثنايا رواياته التي تستلهم من التراث العربي والموروث الشعبي، وهناك كذلك تجارب أخـــرى.
وأوضح مبارك أن من فوائد تأثر الأدب بالفلسفة الابتعاد عن المباشرة والتحليق نحو عوالم لا تحدها حدود، ولابد للمؤلف حتى يصنع نصاً فلسفياً أو يناقش قضايا فلسفية أن يكون قادراً على الالتقاط واستيعاب المفاهيم المعقدة حتى يقدمها بكل يسر للقارئ.
هناك أهمية لتوظيف الفكر والفلسفة والاستعانة بهما من قبل الكتاب القصصيين والروائيين من أجل الاقتراب من الواقع وفهم المجتمعات في سكونها وتحولاتها-كما يرى مبارك-، وتلك مهمة ضرورية ظل يقوم بها السرد على الدوام.محاذير
الروائية وفاء العميمي حذرت من أن يقود توظيف الفلسفة وقضاياها ومواضيعها ومفاهيمها في السرد إلى إنتاج نصوص غامضة أو صعبة لا يقرأها سوى مجتمع النخبة، حيث إن العمل في هذه الحالة يكون محدود الأثر، بالتالي هذا الأمر يتطلب من الكاتب تمرير الحمولة الفلسفية في الرواية دون إخلال بالمفاهيم.
وشددت وفاء العميمي على ضرورة أن يعمل الكاتب على توظيف الرؤى الفلسفية بشكل سليم غير مقحم، بحيث يكون العمل عبارة عن وحدة موضوعية، ويجب كذلك أن لا يعود القارئ في كل مرة إلى المعاجم الفلسفية لفهم ما يريد الكاتب قوله.
مراوغة
«رغم عشقي للروايات الفلسفية لكني أجدها صعبة على القارئ مهما تم تخفيفها»، بتلك الكلمات أعلنت الكاتبة عائشة عبد الله عن موقفها من التوجه نحو الكتابة الفلسفية من قبل المؤلفين، موضحة أن الجمهور في العصر الراهن، صار يفضل الكتابة السهلة التي تتجه نحو المعنى مباشرة بلا تعقيد.
وتذهب عائشة إلى أن هناك العديد من الكتاب التصقوا بالواقع والمجتمع بصورة يومية واستطاعوا أن ينتجوا أعمالاً أدبية مشبعة بروح الفلسفة مثلما فعل نجيب محفوظ عربياً.وأكدت عائشة عبد الله أنها تفضل أن لا يحمل النص الأدبي في القصة والرواية مفاهيم فلسفية معقدة يصعب تمريرها، بل أن يكون هناك أثر يدل على أن الكاتب له رؤية فكرية يضمنها في النص بشكل غير مباشر؛ بحيث يظهر للقارئ أن هذا الكاتب لديه خلفية فكرية لكنها لا تظهر في الكتابة إلا بصورة مراوغة.
تجاوز الحدود
من أهم تلك الكتب التي نقبت عن المضامين والرؤى الفلسفية في الأعمال والنصوص السردية كتاب «الرواية والفلسفة»، من إعداد وتقديم د. زياد أبو لبن، ود. زهير توفيق، ويتناول توظيف الفلسفة والفكر في العمل السردي بشكل خاص في العصر الراهن، ويجيب عن سؤال ضرورة تجاوز الحدود والحواجز الفاصلة بين الفلسفة والأدب، ففي المقدمة أشار كل من أبو لبن وتوفيق، إلى أن المرحلة الراهنة «ما بعد الحداثة» قد تجاوزت الحدود بين الحقلين منذ أفلاطون.
ويشير الكتاب إلى أن إنجاز ما بعد الحداثة يكمن في تجاوز صرامة النص الفلسفي، وطريقة التحليل العقلي التي درج عليها الفيلسوف «الكلاسيكي» منذ أرسطو إلى كانط، وانفتحت الفلسفة على الخيال الروائي والسردي لتقديم أفكارها بطريقة سلسة، وأصبحت الرواية مشحونة أكثر وأكثر بالتفلسف والتأمل، ولم تعد الدرامية والتشويق المجاني في الرواية مطلوباً أو على جدول اهتمام الروائي المعاصر أو كافياً لتقديم عمل إبداعي.
ويؤكد الكتاب على أن السرد التأملي أصبح عملاً وراءه قيمة معرفية وحكمة لا يطولها القارئ والناقد من دون معرفة خلفيات النص ومرجعيات الكاتب، فمن نيتشه الفيلسوف والمبدع إلى هايدجر ومنه إلى المنظر والناقد رورتي انفتحت الفلسفة على الأعمال الأدبية ومنها السرد الروائي، فعملت على تعميقها والوصول إلى القارئ المعاصر، للتعبير عن معاناة الإنسان والقلق وإعادة إحياء المنجز الوجودي.
ويلفت الكتاب إلى أن الحكايات الصوفية كانت معلما بارزاً على التأمل في السرد العربي القديم ومثالاً نوعياً على التداخل بينهما، ذلك التداخل الذي عاد بالفائدة على الطرفين، كما يؤكد الكتاب على أن نصوص كبار فلاسفة عصر التنوير؛ من ديدرو إلى مونتسيكو إلى جان جاك روسو، ما هي إلا الدليل القاطع على هذا التواصل بين السرد الروائي والفلسفة.
ويذكر الكتاب بأن مرحلة ما بعد الحداثة شكلت منعطفاً بارزاً في العلاقة بين الرواية والفلسفة، وبقضية تداخل الأجناس الأدبية إلى التداخل بين الأدب والفلسفة والثقافة خاصة في الرواية التي تجاوزت بنيتها التقليدية إلى التجريب والتداخل، فلم يعد في الرواية شخوص واضحة المعالم، ولا حبكة تتطور بتطور الزمن، فتم تحطيم الزمن الطبيعي لمصلحة النفسي والوجودي والبطولة الإنسانية إلى بطولة المكان والزمان والبطل الإشكالي الذي يتجاوز ثنائية الخير والشر، والحبكة، لمصلحة الفكرة والتأمل والرسالة المشفرة، وتداخلت في الرواية «الفلسفية أو المفعمة بالفلسفة»، اللغة الإشارية الخاصة بالسرد مع اللغة التعبيرية والتقريرية في النص الفلسفي.
تقلبات وصراعات
كتاب «فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة… حوارات مختارة مع روائيين وروائيات»، ترجمة وتقديم لطيفة الدليمي، يؤكد على ضرورة أن تمارس الرواية الحديثة فعل الاقتراب أكثر من الفلسفة في الوقت الراهن، نسبة لحاجتها لذلك الأمر في واقع يمور بالتقلبات والصراعات التي تنتج مشاكل جديدة ومختلفة عن ما كان يسود في السابق.
الكتاب هو عبارة عن حواريات مختلفة مع روائيين وروائيات حيث يتم الاطلاع على تجاربهم في السرد الفلسفي وقراءاتهم كذلك، بما يوفر للقارئ الكثير من المعلومات حول الاتجاهات والتيارات السردية الحديثة وتبيان العلاقة بينها والفلسفة. ويؤكد الكتاب على أن الرواية الحديثة تُعدّ إحدى أدوات المعرفة القائمة على حركيّة الفكر والنزوعات البشريّة والتحوّلات المُجتمعيّة في جوانبها الأخلاقية والجماليّة، وفي الحوارات التي يضمُّها الكتاب نجد التباين والتضاد في آراء الروائيين من جوهر العمل الروائي ودوافعه ومُحفّزاته مثلما تتباين أساليبهم التي تتجاوز في تجريبيّتها مختلف النظريّات المعروفة عن الرواية بوصفها جنساً أدبياً ذا ملامح محدّدة.
ويتحدّث في الكتاب روائيون كبار ومُكرّسون عن الرواية والإبداع الروائي وطرائق الكتابة وطقوسها فيما يخصّ آليّات العمل الأدبي ويلقون الأضواء الكاشفة على حياة الشُّعوب وأساليب عيشها وتعاملها مع مُعضلات الوجود الأساسيّة كالحبّ والجمال والموت والحياة والشغف واليأس والصِّراع من أجل البقاء.
ويتعرف القارئ في الحوارات المختارة التي تضمنها الكتاب إلى جوانب خفيّة من حياة الروائيّات والروائييّن ورؤيتهم للحياة ومواقفهم من أحداث زمننا والمؤثِّرات الفكريّة والفلسفية التي شكّلت شخصيّاتهم وتركت آثارها في نضجهم الوجداني كما نتعرّف إلى الموضوعات التي لطالما كانت مصدر إلهامٍ لهم في عملهم الروائي ونجدُ في اختلاف الرؤى والمواقف والأساليب ما يثـري رؤيتنا إلى فنّ الرواية في الثّقافات المُختلفة، مثلما تكشف لنا هذه الحوارات الفوارق الكبرى بين توجُّهات مبدعي الشرق والغرب والشّمال والجنوب وتباين مواقفهم مما هو ذاتي واجتماعي؛ فنتلمّس طغيان الفردانيّة والذاتيّة المفرطة والنزعات الأبيقورية لدى الغربيين وانكفاءهم على المُشكلات الفرديّة المُتأتّية من ضغوط المجتمع التنافسيّ والتبدّلات القيميّة، بينما يحتكم الشرقيون عموماً في مضامين أعمالهم الروائيّة إلى تبنّي الهموم الجمعيّة والمُعضلات العامّة والتّوق الإنساني إلى الحرّية والكرامة واشتراطات حياة فُضلى وإغفال ما هو شخصيٌّ وذاتيٌّ غالباً.
المصدر : صحيفة الخليج