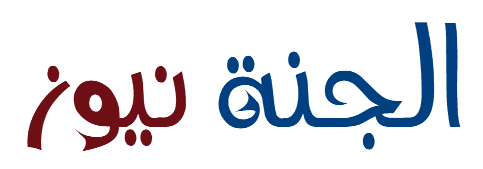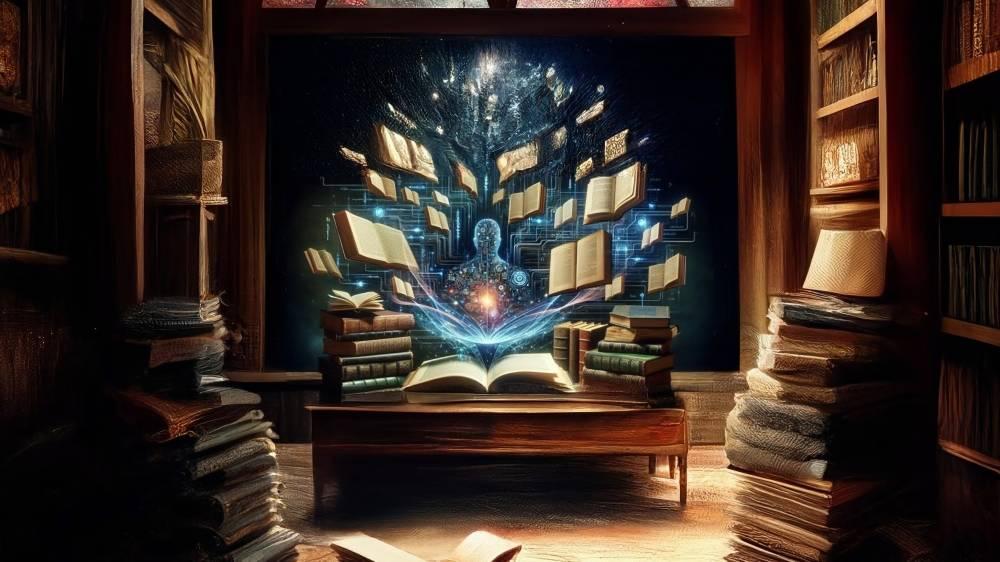
هل تراجع فن القصة القصيرة؟ وهل ترك مكانه شاغراً بعد أن كان هو الإبداع الذي يرصد الحراك الاجتماعي ويعبر عن الأحلام في العالم العربي في أزمنة مضت خاصة في حقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي؟ ولمصلحة أي الفنون والإبداعات تغيب شمس السرد القصير؟ ألا يبدو غريباً أن يتراجع هذا الفن الذي يعتمد على الكتابة القصيرة في عصر تسود فيه ثقافة الاختصار والسرعة و«التيك أوي» وتنتشر فيه وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية؟
الواقع أن كل هذه الأسئلة والإجابات الممكنة والمتوقعة تشير إلى أن هناك مشكلة في هذا النوع من الكتابة الإبداعية وذلك يبدو جلياً في كونه لم يعد ضمن خيارات القارئ بشكل أساسي، وربما ليس كذلك ضمن اهتمامات دور النشر التي كما القراء باتت تفضل طباعة ونشر الرواية والترويج لها، فماذا هناك؟
المفارقة تبدو جلية، ففي حين أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت ملاذ القراء من كل لون تفرض كلمات قليلة ومعينة، مما يشير إلى الكتابة القصيرة هي المفضلة للقراء في هذا الزمن الذي يبدو فيه الجميع منشغلاً ولا يمتلك الزمن الكافي ولا ترف أن ينفق ساعات طويلة في الاطلاع على مادة طويلة، في ظل ذلك، كان الجميع يتوقع أن يكون السرد القصير هو المهيمن على مشهد الأدب والأنماط السردية والذي من أهم سماته التكثيف والاختزال والوصول المباشر إلى المعنى، وهي عملية تعتمد على حرق الكثير من المراحل في البناء السردي، فكلما كان الكاتب القصصي صاحب تجارب متراكمة، كلما امتلك القدرة على إنجاز نص قصير يحمل كل شروط القصة القصيرة التي تعبر عن مشهديات خاطفة والتقاطات لماحة وذكية لمواقف حياتية واجتماعية يفرزها الواقع اليومي.
إلا أن المفاجأة كانت في وجود مؤشرات تدل على تراجع موقع ومكانــــة القصة القصيرة، بل وكــــان الأغــــرب أن فناً يعتمد عــلى التطويــــل والإسهاب صار يحتل المكانة الأولى في عالم الأدب والكتابة الإبداعية ألا وهو فن الرواية والتي لا مكان فيه للاختزال، حيث إن الوصــــف المسهـــب بكل أنواعه هو من أهم تقنياته، كما أن العمل الروائي نفسه ينجز في وقت طويل، ويتطلب جهداً بدنياً وفكرياً ونفسياً، حيث يعمل الكاتب في أوقات قد تصل إلى سنوات من أجل إنجاز رواية واحدة، إذ يبدو الإبداع الروائي وكأنه يسبح ضد تيار العصر لكنه رغم ذلك ينتصر،
وأصبح مصـــدر الاهتمــام الأول للقارئ، وباتت تهتم به دور النشر بصورة كبيرة، وفي كل معارض الكتب العالمية والعربية نجد الغلبة للرواية بينما تقبع المجموعات القصصية في ركن قصي، مما يدل على أن هذا التراجع في القصة القصيرة هو شأن عالمي وليس حصراً على الوطن العربي فقط.
بدايات
بدايات القصة القصيرة في العالم العربي جاءت باكرة حيث يشير العديد من المؤرخين إلى أن أول قصة فنية ظهرت بالشكل المتعارف عليه؛ أي تحوي عناصر السرد القصير وتقنياته وشروطه كاملة هي قصة «القطار»، لمحمد تيمور التي نشرت في جريدة السفور عام 1917م، وقال آخرون بل هي قصة «سنتها الجديدة»، لميخائيل نعيمة، التي نشرت في بيروت عام 1914م؛ وسرعان ما تعزز وجود هذا النوع الإبداعي وبشكل خاص في حقب الستينات والسبعينات إلى الثمانينات من القرن الماضي، وبرز العديد من الكتاب الذين كانوا بمثابة نجوم لامعة في سماء هذا الفن الجميل ومنهم: محمد حسين هيكل ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس، غادة السمان، محسن يوسف، وغسان كنفاني، ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، وعلي المك، وفارس زرزور وفي الإمارات هناك شيخة الناخي، وعبد الله صقر، ومريم جمعة فرج، وناصر جبران وإبراهيم مبارك، وغيرهم حيث كان هناك اهتمام كبير بهذا الفن.
غربة
وعلى الرغم من التاريخ المجيد والطويل للعرب في فن القصص والحكايات، إلا أن القصة القصيرة لم تكن نتاج ذلك التاريخ والتراث، كما أنها لم تنبع من البيئة والواقع بشكل مباشر، رغم تعبيرها عنه، حيث جاء السرد القصير من بوابة التأثر بالأدب الغربي ورواد فن القصة القصيرة هناك من أمثال: فرانز كافكا، وأنطوان تشيخوف، وإدغار ألن بو، ودستويفسكي، وماركيز وغيرهم، لكن العرب استطاعوا أن يبدعوا في هذا المجال ونجحوا في خلق حالة سردية متوهجة.
تاريخ فاصل
ثم جاءت مرحلة بدأت القصة القصيرة في التراجع، وتسيدت الرواية سردياً منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي؛ أي أن القصة القصيرة كان لها وجود قوي ومؤثر في أزمنة لم تتسم بالسرعة بل بالبراحات الزمنية والعلاقات الاجتماعية القوية، فيما سيطرت الرواية في عصر الفردانية وتشظي الروابط الاجتماعية بفعل المشاغل ونمط الحياة السريع، وذلك أمر يبدو غريباً، وكأن شمس القصة القصيرة تغرب في أوان شروقها، في اللحظة التي كان من الممكن أن تكون فيها هي الأدب الذي يتماهى وينسجم منطقياً مع هذا العصر البخيل، ولكن يبدو أن تلك ليست هي المفارقة الوحيدة.
حواضن
كانت الصحف والمجلات هي الحواضن الأولــــى للقصة القصيرة في العالم العربي منـــــذ بداية نشر أو عمل قصصي، ومع الانتشار الكبير للجرائد بحلـــــول نهايــــة القــــرن التاسع عشر فــــي مصــــر ولبنـــــان وسوريا وعــــدد من الدول العربية، انتشرت القصة وتوسعت وهيمنت على المشهد الثقافي بشكل كبير، بل وكانت تنشر كذلك الأعمال القصصيــــة القصيرة المترجمــــة من الأدب الغربي وغيره، مما شكل علاقة قوية بين القراء المهتمين بالشأن الثقافي والصحف والمجلات في تلك الحقبة، وإلى جانب القصص، كانت تلك المطبوعــــات تفــــرد حيزاً مقــــدراً للنقــــد الأدبي فــــي مجال القصة الأمر الذي زاد من حيوية الحراك الثقافي والسردي، وزاد من توزيع الصحف حيث كانت الملاحق والصفحات الثقافيــــة مقصداً للكثير من الكتاب والقراء.
قطيعة
واليوم يدفع الكثيرون بأن القصة تراجعت عندما بدأت في مفارقة حاضنتها، حيث تخلت الصحف عن مهمة نشر الأعمال القصصية، وهنا أيضاً تكمن مفارقة أخرى، حيث إن الصحف لم تعد هي وحدها منصات الكتابة الأدبية، فاليوم ومع التطور التكنولوجي برزت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة التي يمكن أن تكون فضاء تحلق فيه الروائع القصصية، خاصة أن هذه التقنيات متناسبة مع كتابة القصة من حيث الحجم وعدد الكلمات، وبالفعل نجد أن منصات مثل الـ«فيس بوك»، و«إكس»، وغير ذلك تضم صفحات ومجموعات مهتمة بالكتابة الإبداعية، وتنشر فيها أعمال قصصية بتفاعل مباشر مع القراء، ولكن رغم ذلك القصة القصيرة لم تعد ذلك الفن الذي كان متألقاً في أزمنة مضت.
الومضة
على الرغم من أن التكنولوجيا الحديثة والرقمنة شجعت على انتشار سرد أقصر من القصة القصيرة وهو المتمثل في «القصة الومضة»، و«القصة القصيرة جداً»، لكن ذلك لم يعد الألق لكتابة القصة القصيرة، فالشاهد أن هناك العشرات من المجموعات والصفحات المهتمة بنص «الومضة» التي صار لها كتاب متخصصون وتنشر حولها العشرات من الدراسات النقدية من دون أن يكون لها أثر مباشر مثلما تفعل الرواية، ولعل مما أضعف مركز القصة القصيرة أو القصيرة جداً، أن صغرها هذا أغرى الكثيرين بالكتابة فيها ربما بلا موهبة أو إمكانيات، وذلك أدى إلى صدور كتابات وإصدارات كثيرة ولكن بلا أثر حقيقي، لكونها لا تراعي شروط السرد القصير الذي يتطلب المهارة والأسلوب المتميز والخبرة والمزج بين الفكرة والأبعاد الجمالية، لقد أغرق المجال بالكتابات التي ظنت السهولة في هذا الفن الذكي
هجرة
لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع القصة القصيرة، أن العديد من كتابها غادروا ساحتها، وترك الرماة مواقعهم في هجرة نحو الرواية التي أصبحت سيدة الموقف من حيث تفضيل القراءة وكذلك إلى جانب القيمة التسويقية والجوائز والمسابقات، الأمر الذي أفقر مجال السرد القصير، حيث كانت تلك الهجرة من أكبر العوامل التي أثرت في مكانة القصة القصيرة، بينما يرفض الكثير من الكتاب المتمسكين بهذا النمط الإبداعي المقارنة بين الرواية والقصة، حيث إن كلاً منهما فن قائم بذاته وإن اشتركا في التعبير عن الواقع والقضايا الإنسانية، وربما يتجلى هذا الجدل بشكل كبير في كتاب إبراهيم نصر الله أو روايته «مأساة كاتب القصة القصيرة»، الذي يتناول بصورة سردية إبداعية تلك الفوارق، إذ يرى صنع الله أن القصة القصيرة هي «قمة الصفاء الإبداعي وكثافته».
إبـداع يحـتاج إلى الوعـي
عدد من الكتاب تحدثوا إلى «الخليج»، عن واقع القصة القصيرة اليوم، والآفاق الممكنة لعودة ألقها القديم، حيث أشاروا إلى أن المفارقة في كون أن هذا الفن يغيب في وقت تهيأت له أسباب الازدهار صحيح، إلا أن هناك عوامل أخرى أدت إلى ذلك التراجع المشهود.
الكاتب محسن سليمان، أشار إلى حديث متداول عن «موت القصة القصيرة»، وهو ضمن سلسلة من الآراء، المثيرة على شاكلة «موت المؤلف»، و«موت الناقد»، وغير ذلك، ولعل انتشار خبر «موت القصة»، يعود إلى حقيقة انحسار هذا الفن وقلة انتشاره مقارنة بسنوات مضت حتى لحظة بداية التطور التكنولوجي الكبير في أزمنة العولمة والثورة الرقمية.
وأرجع سليمان تراجع القصة في الوقت الراهن إلى تقلص عدد صفحات الجرائد والمجلات الثقافية، إلى جانب أسباب أخرى، وبينما كانت القصة هي ابنة الصحافة، صارت اليوم ضحيتها، إذ لم تعد الجرائد تهتم بها في ملفاتها وصفحاتها المتخصصة.
وعلى عكس الرائج، فإن سليمان يشير إلى أن تطور التقنيات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي عوامل أدت إلى تراجع القصة القصيرة وليس ازدهارها، ويعود ذلك إلى هيمنة الصورة التي باتت تطغى على كل فن أو إبداع آخر، كما أن الترويج للرواية عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي هو نوع من التورط في إهمال القصة، فذلك الاهتمام الزائد هو تهميش للسرد القصير.
ويؤكد سليمان على أن تراجع القصة أو عدم انتشارها لا يعني موتها أو نهايتها، فهي فقط بحاجة لجملة من العوامل من أجل عودة البريق ومنها الاهتمام بالكتاب وبهذا الفن من قبل المؤسسات الثقافية، وربما أن التحول إلى أشكال القصة القصيرة جداً هو المستقبل، فهذا النوع من القص أفضل في عصر التكنولوجيا والسرعة بسبب أنها قائمة على الاختزال والتكثيف والمفارقة، كما أن هناك حاجة إلى التواصل مع الأجيال الجديدة، وزيادة مستوى الوعي المعرفي بمفهوم القصة القصيرة.
وقال سليمان: «صحيح أننا نعيش عصر السرعة والجمل المختصرة ولكن للقصة مفهوم مغاير، فهي تحتاج إلى تقنيات وإمكانيات ذهنية فهي محرك فكري تمنح القارئ مسحة إبداعية للتأمل والتفكير في الحدث والمصائر».
ذكاء اصطناعي
الكاتبة أسماء الزرعوني، شددت على أن أجيال الرواد من كتاب القصة القصيرة ما زالوا يحافظون على تقاليدها، فهم يمتلكون الخبرات الكافية لكتابة هذا الفن المختلف والذي هو أكثر صعوبة من الفنون السردية الأخرى مثل الرواية، وذلك لأن الكاتب يتعامل مع زمن محدود، ويمارس فعل التكثيف والاختزال من أجل إيصال فكرة معينة وذلك يتطلب جهداً ذهنياً كبيراً.
ولفتت إلى أن زمن السرعة والانتشار لمنصات التواصل الاجتماعي أدى إلى تشجيع نمط سردي جديد وهو المتمثل في القصة القصيرة جداً أو القصة الومضة، والتي، رغم انتشارها الكبير، لديها العديد من المشاكل فهي بلا روح أو متعة وغير محرضة على التأمل والتفكير وتعتمد على المفارقة فقط في الغالب.
وكشفت أسماء الزرعوني عن أن الكثير من كتاب القصة الومضة يستعينون بالذكاء الاصطناعي في كتابة نصوصهم، وأن كل من يمتلك خبرة في كتابة القصة يجد ذلك الأمر واضحاً وجليا.
وقالت أسماء الزرعوني: «إننا نعيش زمن الرواية، التي تشهد ازدهاراً كبيراً لكونها قد استقطبت حتى كتاب القصة القصيرة ولأنها تجد ترويجاً أكبر في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنال اهتماماً من المؤسسات من خلال الجوائز بعكس القصة».
معايير مختلة
القاص صالح كرامة، أكد على أن العالم يعيش بالفعل في عصر السرعة والاختزال، ولكن ليست هكذا تقاس الأمور بالنسبة للقصة القصيرة، حيث إن هناك عوامل أنتجت هذا الوضع أهمها أن السرد القصير هو فن شديد الصعوبة ويحتاج إلى تمرس وخبرة وزمن من أجل التقاط الفكرة وإثرائها بالأفكار والرؤى الفلسفية العميقة ومن ثم تحويلها إلى نص مختزل، وذلك بعكس فكرة سرعة العصر التي لا تمنح براحات للتأمل والعمق.
ونوه كرامة بأن ما يجعل الرواية مهيمنة في هذا العصر هو كون عوالمها فضفاضة ولا يبذل فيها ذات الجهد الفكري الذي تحتاج إليه القصة، فالرواية ليست قصة طويلة كما يشاع، كما أنها؛ أي الرواية استفادت من المنجزات الإعلامية والرقمية للعصر أكثر من القصة جهة الترويج.
وشدد كرامة على أنه من غير الممكن الحكم على القصة القصيرة بالفناء أو الموت، لأنها فن أصيل يترجم المعاناة ويعبر عن الواقع، ويلتقط الأفكار والمشاهد الصغيرة غير المرئية، لذلك تظل هي الإبداع الأثير لدى الكتاب من أصحاب المواهب والإمكانيات الحقيقية، فـ«الإسهاب سهل وتكمن الصعوبة في الإيجاز».
وأوضح كرامة أن هناك سيلاً من الكتابات القصيرة والمختزلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي أتاحت للجميع أن يمارسوا فعل الكتابة، لكن تلك المساهمات المختزلة لا يرتقي الكثير منها إلى مستوى القصة القصيرة أو حتى الومضة، فهي لا تستند إلى تقنيات القص، وتطلق بلا موهبة أو معرفة.
ذائقة استهلاكية
«رغم أن سياق الحياة يستدعي الاعتقاد بأننا نعيش زمن القصة القصيرة، إلا أني غير متفاجئة بتراجع هذا النوع الأدبي»، هكذا تحدثت القاصة عائشة الكعبي، والتي أوضحت أن هذا الفن الإبداعي لم يصل إلى تميزه نتيجة قصر متنه فقط، بل هو جنس أدبي نشأ وتشكل على أيدي أعظم المفكرين وأعمق المحللين، ولم يحدث أن عزى أحدهم نجاح هذا النمط تاريخياً لقصره وإنما لقدرته على الجمع بين عمق الفكرة وإيجاز السرد في آن واحد.
وذكرت عائشة الكعبي؛ أن كتابة القصة القصيرة هي حرفة تتطلب وجود قدرات لم تعد دارجة بين جيل نشأ على مفهوم التوصيل السريع للبضائع والأخبار والأفكار أحياناً، بغض النظر عن طريقة تغليف هذه الأفكار، كما لا تشك أن انحسار الدور الذي لعبته الصحف والمجلات والمجالس الأدبية في تشذيب الذائقة الأدبية سابقاً نتج عنه تراجع جودة القصص القصيرة خاصة مع بداية ثورة النشر الإلكتروني الذاتي، مما دفع القارئ للعزوف عنها لصعوبة العثور بينها على النص المميز.
ولفتت إلى أن الذائقة الاستهلاكية تبقى في النهاية هي أيضاً سمة من سمات العصر، وهي التي تحدد رواج جنس أدبي أكثر من الآخر لأسباب عدة مما يفسح المجال للقصة القصيرة بالانزواء مؤقتاً.
مفارقة
الناقدة الدكتورة زينب الياسي المختصة بتدريس الكتابة الإبداعية، أشارت إلى أن الكاتب بات يمارس فعل الكتابة استجابة لخيارات واحتياجات المتلقي، من لقطات سريعة توفرها القصة الومضة والخواطر والشذرات، غير أن القصة القصيرة التقليدية هي فن مختلف وتحتاج إلى مساحات من الهدوء والتفكير والجهد العميق والجلوس لساعات طويلة بحثاً عن فكرة، لذلك فالنص مختزل لكن يحتاج إلى وقت في إنجازه من قبل الكاتب، وزمن لتدبره من قبل القارئ.
وأوضحت زينب الياسي، أنه على الرغم من أن مواقع التواصل قد أبرزت القصة الومضة، إلا أن الكثير من تلك الكتابات ليست ذات محتوى جيد، كما أن ممارسيها لا يعترف بهم في الوقت الراهن ككتاب، ولم تجمع هذه القصص القصيرة جداً بين دفتي كتاب إلا نادراً، ولا يعرف حتى الآن إن كان سيستمر هذا الفن مستقبلاً أم سيتلاشى.
تأثير عميق
يعالج كتاب «جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل… قراءات في السرد القصصي المعاصر»، للناقد رامي مصطفى هلال، القصة القصيرة في وضعها الراهن بالتطبيق على عدد من المؤلفات، حيث يضعنا في قلب التحولات التي مر بهذا النوع السردي الأثير لدى القراء العرب خاصة في أوقات سابقة.
ويقدم الكتاب عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بفن القصة القصيرة، حيث يقسّم المؤلف الإصدار إلى قسمين نظري وتطبيقي، ويركز في الجانب النظري على السرد من حيث المصطلح والتاريخ، والخطاب الشعري وعلاقته بالقصة القصيرة، مقدماً تطوافاً معرفياً بديعاً بين الماضي واليوم، مع التركيز على السرد القصصي المعاصر وشؤونه المختلفة والتحديات التي تواجهه في العصر الحديث، خاصة مع الهيمنة الكبيرة للرواية، ويشير الكتاب إلى أن التطور العملي والاجتماعي في العصر الحديث كان له تأثيره الكبير والعميق في التطور الفني للأشكال الأدبية والسردية المختلفة، بحيث جعل الإبداعات تتنوع وتتعاون وتتداخل.
والكتاب يعلن انحيازه لفن النصوص القصيرة الجميل، نافياً أن يكون هذا الإبداع في لحظة تلاشيه الأخيرة، رغم وجود إبداعات أخرى تنافسه، ويؤكد المؤلف أن القصة القصيرة هي الفن الذي لا يزال يشق طريقه بين الفنون الأدبية، ويحاول في عصر الرواية المهيمنة أن يسرد الوجود على طريقته، وأن يقدم من بين آلاف الحوادث اللحظات الأكثر تكثيفاً وخصوبة، وأن يقرب الوعي الإنساني من وجوده، كما يعزز وجوديته، ويلفت النظر من خلال زاوية الرؤية فيه إلى المدهش الكامن في العادي والهامشي.
يعزز الكتاب من فرضية تعايش الإبداعات الأدبية والسردية المختلفة ويخدم البشر ويعبر عن واقعهم، فللقصة القصيرة خصوصيتها الإبداعية التي تتميز بها عن الأشكال والأنماط الأدبية الأخرى، إذ تختلف في فكرتها وبنائها وأدواتها السردية عن بقية الأجناس مثل الرواية وغيرها، فهي الفن الذي يجيد لحظة الالتقاط والتركيز على الأشياء والنقاط الصغيرة التي لا يلتفت إليها أحد، وكل ذلك يتوقف على مقدرة الكاتب نفسه وخبرته وأسلوبيته، فكتابة القصة تحتاج بالفعل إلى موهبة خاصة.
وفي الجانب التطبيقي، يقدم قراءة لمنتجات قصصية هي ابنة الوقت الراهن ومنها: «ثنائية الغياب والحضور قراءة في محطات للغياب» لمحمود عرفات، «دوائر السرد المتداخلة» قراءة في «كأنني حي» لمحسن عبد العزيز، الرؤية الصوفية في «جدتي تحكم العالم ليلاً» للقاص سمير المنزلاوي، تقنيات سرد المهمشين في «وجوه خارج الكادر» لصلاح هلال، «فاتحة للسندباد» للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، شاعرية السرد التجريبي في «تراب ودانتيل» لإبراهيم قنديل، الراوي الشعبي الساخر في «زعابيب أمشير» لشعبان ناجي، النزوع الأنثوي نحو الاكتمال قراءة في «جبال الكحل» لكاميليا عبد الفتاح، السرد الكاشف.. قراءة في مجموعة «إفلاس دولت» لأماني الشرقاوي، تداخل العوالم والأثر الشعري في «سبع عربات مسافرة» لمحمد زهران، تداخل الأنواع الأدبية في مجموعة «رقص مصاصي الدماء» لمحمد ربيع حماد.
مرجع كلاسيكي
كتاب «فن القصة القصيرة»، للكاتب الدكتور رشاد رشدي، فهو من المراجع المهمة التي تحيط بجوانب عديدة وتقدم موضوعات متنوعة، حيث يشير الكتاب إلى أن القصة القصيرة هي فن حديث لم تعرفه الآداب الغربية إلا منذ حوالي قرن، غير أنه لا يُعنى بتاريخ هذا النمط الإبداعي، بقدر ما يبحر في أصوله وقوانينه وتقاليده التي صنعتها أجيال تعاقبت على كتابته، حيث يتبع الكاتب في مؤلفه هذا منهج الاستقراء والتحليل والمقارنة، فيجد القارئ أمثلة من القصص العالمية التي يقوم الكاتب بتحليلها ومقارنتها بغيرها من القصص مما يساعد على إيضاح الأسس الفنية لكتابة القصة القصيرة.
الكتاب يقع في عدد من الفصول، وفي البداية يقدم نبذة أو ملمحاً بسيطاً ومهماً عن تاريخ القصة القصيرة ونشأتها حيث يبرز ظهور هذا الفن في أواخر القرن التاسع عشر، وما يمتلك من خصائص ومميزات شكلية مُعينة، ويتناول أولى محاولات كتابة القصة القصيرة منذ القرن الرابع عشر في روما في نمط فني يدعى «الفاشيتيا»، وظهور الكاتب الفرنسي دي غي موباسان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي يعتبر من الآباء المؤسسين للقصة القصيرة الحديثة وكان يرى أن اللحظات العابرة التي نراها كل يوم تستحق أن نكتب عنها، ولا يلزم أن يختلق الكاتب عالماً جديداً، وأبطالاً وهميين، بل بإمكاننا أن نكتب عن أناس عاديين.
ويتحدث الكتاب في الفصل الثاني وحتى الرابع عن بناء القصة القصيرة، حيث يستهل ذلك المشوار بعنوان «الخبر والقصة»، يؤكد من خلاله على ضرورة أن تروي القصة أخباراً ترتبط مع بعضها، وأن تكون للخبر بداية ووسط ونهاية، ويقدم الكتاب عدداً من النماذج الدالة على ذلك، ويخلص إلى أن وجود عدة أخبار مجتمعة جنباً إلى جنب لا يكفي؛ حتى يتحول العمل إلى قصة، بل يجب أن تكون الأخبار مرتبطة ببعضها، وأن يأتي كل منها نتيجة للآخر؛ حتى تعطي أثراً كلياً، ثم يتوقف الكتاب عند بناء القصة تحت عنوان «الشخصيات».
ويتناول الكتاب بناء القصة كذلك من حيث «المعنى»، حيث لا توجد قصة بلا معنى، كما لا يوجد حدث بدون غرض، ويقدم المؤلف عدداً من النماذج من النصوص العالمية التي تحتفي بالمعنى، ثم ينتقل الكتاب للحديث عن بناء القصة من حيث «لحظة التنوير»، وهي المتعلقة بخاتمة الحكاية التي يجب أن يتوفر فيها المقصد والرسالة وأن تكون موضحة لما يريد أن يقوله مؤلف القصة، حيث يتناول بالشرح عدداً من القصص التي احتوت على خاتمة لامعة برزت فيها خلاصة السرد.
وفي الفصل السادس ينتقل الكتاب للحديث عن «نسيج القصة»، متناولاً بعــض المواضيع ذات العلاقة بتكوين الحكاية ويقدم بعض النصائح حول الوصــــف الذي يجب أن يساهم في تطوير الحدث إلى جانب العناصر الأخرى، ويركز الكتاب فــــي هذا الفصل كذلك على الحوار واللغة وتفكير الشخصيـــات داخـــــل القصـــة، حيــــث يشير إلى أهمية ألا تتحدث الشخصية بلغة غير لغتها.
المصدر : صحيفة الخليج