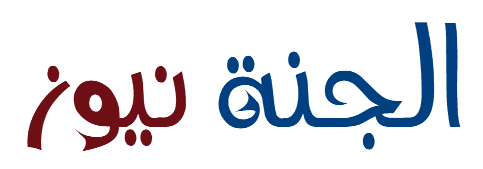وجه الفنان محمد إمام، رسالة للجمهور، وذلك بعد تغيير مخرج فيلمه الجديد شمس الزناتي، والمقرر بدء تصوير خلال الفترة المقبلة.
تغيير مخرج فيلم شمس الزناتي

تفاصيل فيلم شمس الزناتي
ويعد فيلم شمس الزناتي هو يجمع بين تعاون مصري وسعودي، ضمن نشاطات صندوق big time وهو المشروع الذي اعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقد من قبل، وتحدث فيها مخرج العمل السابق عمرو سلامة قائلا: فيلم شمس الزناتي اللي احنا بنعمله دلوقتي بيحكي احداث ما قبل الفيلم الأصلي، فهو مالوش اي دعوة بأحداث الفيلم الأصلي هو بيحكي قصة ما قبل الفيلم ده.
ومن المقرر أن يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي، مجموعة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، احمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد انورـ احمد عبدالله محمود، احمد عيد الحميد، والعمل السينمائي من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد الدباح.
وفي سياق مشترك، ينتظر الفنان محمد إمام عرض فيلم صقر وكناريا، الذي يشارك في مع الفنانة ياسيمن صبري، يسرا اللوزي، يارا السري، خالد الصاوي، بجانب عدد آخر من النجوم المميزين، ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم صقر وكناريا، حول محمد إمام الذي يجسد شخصيية شاب يدخل في قصة حب مع يارا السكري، والتي تعمل مصممة أزياء، وشقيقتها يسرا اللوزي وهي متزوجة من شيكو، اما الفنانة انتصار فهي تشارك في العمل بشخصية يسرا والده يسرا اللوزي، ويارا السكري، ومن المفترض ان يحقق العمل نجاحا كبيرا بالسينمات.
آخر أعمال محمد امام
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام، هو فيلم اللعب مع العيال الذي تم عرضه في عام 2024، بدور السينما المصرية، وحقق العمل السينمائي وقت عرضه نجاحا كبيرا.
المصدر : تحيا مصر