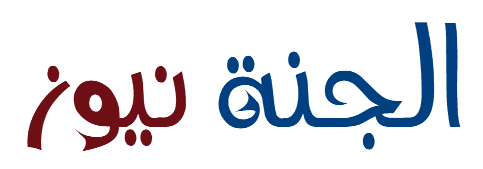رئيس الوزراء يلتقي وزير الطيران المدني لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “مبنى 4” بمطار القاهرة الدولي

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “مبنى 4” بمطار القاهرة الدولي.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى دوره الحيوي في إحداث تحول نوعي للمطار، موضحًا أن المشروع يجسد حجم التطورات التنموية والنهضة الحضارية الجارية في مختلف القطاعات.
الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد يُتوقع أن تصل إلى 30 مليون راكب سنوياً
وأوضح وزير الطيران خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المالية والفنية المتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد يُتوقع أن تصل إلى 30 مليون راكب سنوياً.
وأضاف: أنه سيتم اعتماد أحدث التقنيات الذكية، التي ستجعل المبنى الجديد من بين أكثر مباني الركاب تقدمًا عالميًا، بما يتيح تقديم خدمات وتجارب سفر فريدة واستثنائية.
التفاصيل حول مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة الدولي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني أبرز التفاصيل حول مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، موضحًا أن هذا المشروع يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية بالمطار، بالإضافة إلى دوره في زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار لتصل إلى 60 مليون راكب سنويًا.
كما أكد “الحفني” أن المشروع سيرتكز على أنظمة متطورة، وتطورات تقنية متقدمة في تشغيل المطارات، تشمل مجالات الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني، إلى جانب البنية التحتية، كما سيتم دمج تقنيات مبتكرة تعتمد على أحدث الابتكارات ونتائج الأبحاث والتطوير، بهدف إنشاء بيئة ذكية شاملة وأكثر استدامة.
المصدر : تحيا مصر