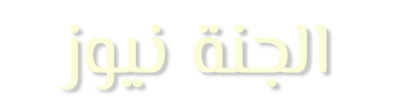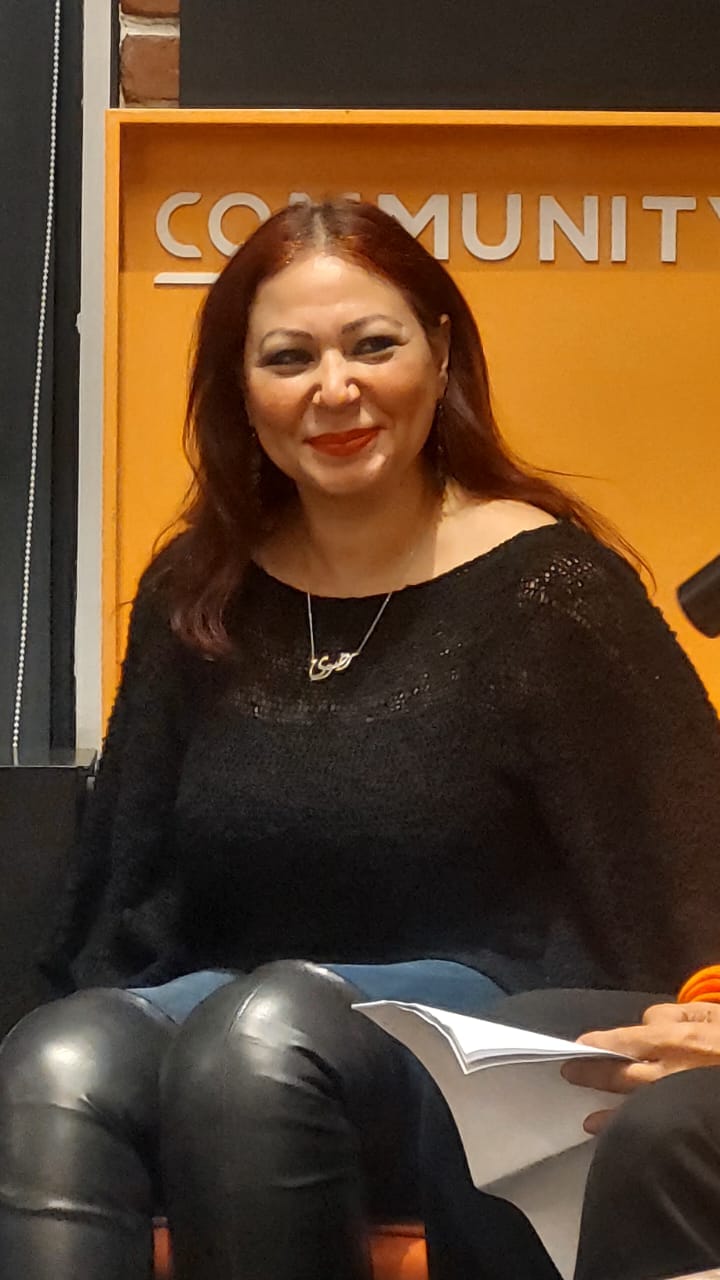لعل من المفيد – ابتداء – أن نفرق بين “الحكاية” و”الحبكة”، فمن خلال هذه التفرقة نستطيع مقاربة جماليات النص السردي، ومعرفة كيفية حركة البنية الزمنية التي تتبع خطاً تصاعدياً في “الحكاية” كما يفترض حدوثها في الواقع، بينما تقوم “الحبكة” على خيال الكاتب وتلاعبه بوحدات الزمن، فقد يبدأ من ذروة الأحداث ثم يرتد إلى الماضي أو يستشرف المستقبل. وهذا ما فعلته المصرية رضوى الأسود في روايتها “أوجه عديدة للموت – تلاوات البعث” (دار العين). وإذا كان العنوان – كما يقال دائماً – عتبة دلالية أولى، فسنلاحظ أننا أمام عنوان كاشف لمحتوى الرواية التي تستعرض صور الموت المختلفة في مقابل تلاوات الساردة لأناشيد البعث، كأنها التعويذة التي تطرد بها هذا الموت الذي يحاصرها.
وبهذه المعاني تتجاوز الرواية المستوى الظاهري المتبدي على سطح السرد، والذي يدور حول علاقة المرأة المحبة المخلصة لرجل متزوج وأب لابنتين ومتعدد العلاقات النسائية، مما دفع المرأة العاشقة – وهي التي تقوم بدور الساردة على مدار الرواية بضمير المتكلم – إلى وصفه على استحياء بأنه “زير نساء”، وأنه يجعل من الحب أو من ادعائه غطاءً لرغباته الجنسية، وهذا ما يعد توطئة لحديثها المتكرر عن “ماهية الحب”، مستعيرة قول إريك فروم إنه “ليس مجرد شعور قوي، إنه قرار، إنه حكم، إنه وعد”، أو هو “موقف، اتجاه للشخصية، تحديد علاقة الشخص بالعالم كله”. وإذا كان هذا تعريف فروم فإن الساردة ترى في الحب “كل المتناقضات مجتمعة”.
وهكذا نكون أمام سرد يتأمل قضايا وجودية تنطلق من هذه العلاقة الثنائية الظاهرة والمتجاوزة لها في آن واحد. وثيمة الجمع بين المتناقضات تحيلنا إلى ما أشارت إليه الساردة في موضع آخر عن ثنائية “الروح والجسد” لتوضيح الفرق بينها وهذا العاشق، حين تقول “إن ما يجمعنا هو الغريزة، غريزتك، شهوتك الملحة وغايتك الأثيرة، أحببت روحك، إلا أنك أحببت جسدي”. وهنا يصبح الفكر المتحرر الذي يدعيه ذلك الرجل مجرد قناع يخفي وجهه وكينونته الحقيقية، فهو “ذكوري حتى النخاع مهما أظهر من فكر متحرر”. وتستمر آلية المقارنة بين الرجال والنساء في محاولة لفهم دوافع تخلي هذا العاشق عنها، فالرجال يعتريهم الملل من استمرارية علاقة ما أو المكوث مع امرأة واحدة، أما الصبر الذي تمتلكه المرأة فهو الذي يجعلها تمتثل للضجر وتروضه كي تستمر الحياة.
الممحاة والذاكرة
تبدأ أحداث الرواية من لحظة الذروة، من مرض الساردة وشعورها بثقل جسدها وعدم قدرتها على الحركة وهي على سرير أحد المستشفيات، حتى إن الممرضة كانت تصفها بالمرأة “الميتة” ومع ذلك كان عقلها لا يكف عن الإدراك والعمل، فتستعيد ماضيها القريب ويصبح الزمن هو القوة القاهرة لذاكرتها وأشبه ما يكون بالممحاة الضخمة المتغلبة على سلطة الذاكرة. وفي هذه الحالة تشعر الساردة بالرعب “ففقدان الذاكرة فزع حقيقي”. وهكذا يظل الصراع دائراً بين الزمان الذي ينسي والذاكرة التي تستعيد. إن الزمن كما تقول الساردة “يباعد بيننا وبين لحظة مررنا بها، يحاول فصلنا عنها، لكن تأبى الذاكرة فتظل لحظة ما هي المدار الذي نظل نطوف فيه”، غير أن هذه اللحظة لا تلبث كثيراً وتستحيل ضباباً سرعان ما يتلاشى.
وهذا الصراع يتوازى مع إحساس الساردة بحالتها البرزخية، كما تتضح هذه البرزخية في مشاعرها تجاه أبيها التي يمتزج فيها الإعجاب بالحسرة والحب بالكره والثقة بالريبة. والحق أن علاقة الأب والأم كانت تجسيداً استباقياً لعلاقة الساردة بحبيبها، فخذلان الرجل – الأب والحبيب – للأم والابنة هو الجامع بين التجربتين، وعانت الساردة من مرارتهما، مرة من الأم في طفولتها وصباها ومرة من حبيبها في شبابها. وتقول “كان كل شيء بالنسبة لي بديلاً عن العائلة المكونة من أب دائم الغياب وأم حاضرة الغياب”. ظلت معذبة بين غياب الأب وجفاء الأم إذ لم تر في الأمومة “سوى جفاف المشاعر، وسوى أرض قاحلة عاجزة عن الإثمار”.
هذا الجفاء الذي حاولت مقاومته بامتلاكها روحاً طفولية واستعانتها بالكتب التي وجدت فيها عزاءها. هذا النهم الثقافي يتجلى في عدد من ملامح السرد، ومن ذلك كثرة التضمينات حين تثبت خطاب ريلكه إلى لو آندرياس سالومي، أو مقولة شمس الدين التبريزي “يجوز الربا في الحب، فمن أعطاك حباً رده ضعفين”، أو قول سيوران “نحن نحب ما نعتقده وليس ما هو حقيقي، نحن نحب الصور التي نصنعها في أذهاننا وليس الأشخاص الفعليين”. وهذه المقولات تتوافق مع فكرة “الحدث” الذي يعتمد عليه الصوفيون بوصفه إحدى وسائل المعرفة. وفي هذا السياق تأتي نبوءات العرافة التي نصدها لأننا نود تصديقها، واستدعاء حب الساردة – على عادة الصوفي – للعزلة والوحدة منتظرة لحظة الاستنارة التي تشبه لحظة الإشراق عند الصوفية، “لحظة الأنوار الإلهية التي تتجلى في قلب العارف”. ويعد علم النفس أقرب العلوم إلى التصوف لأنه يتعامل مع النفس الإنسانية، لهذا يكثر استدعاء أعلامه مثل كارل يونج ونانسي إروين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بطبيعة البحث الاستقصائي التي تعود إلى كون الكاتبة باحثة أيضاً، تتوقف أمام دلالات الموت غير مكتفية بالمعنى الشائع له فترى أن العيش مع أناس لا حديث بينهم نوع من الموت، ومن هذه الأنواع أيضاً “وفاة الأقربين، وقهر الآباء وعقوق الأبناء وخذلان الحبيب”. لذلك فنحن كلنا موتى، لكن “بيت القصيد” الذي تدور حوله الساردة أنها تعد التبعية القلبية لرجل صورة من صور الموت، لأن المحب يكون – في هذه الحال – مسلوب الإرادة وغير قادر على الاختيار الحر، فالحب عماء كما صرحت بذلك في مواضع كثيرة. وكما تعددت صور الموت نجد صوراً عديدة للحلم، فهناك ما يمكن أن نسميه بالحلم الكاشف، فبعد أن ترى حبيبها في أحد هذه الأحلام “جلداً على عظم” وأنه كلما حاولت الإمساك به ينسال من بين يديها كهلام، تقول “الحلم وما بعده هو ما كشفك أمامي”، لكنها لم تستفق ولم تستجب لنذير هذا الحلم. وهناك الأحلام التي “تخيم عليها الواقعية السحرية”، وهناك الحلم الذي يتحول إلى كابوس حين رأت أن حبيبها جاءها بهدية كبيرة معقودة بأربع أناشيط، فكانت كلما فكت واحدة تستحيل ثعباناً يزحف نحو الأرض ويلتف حول قدميها، وعندما استغاثت بحبيبها رأت وجهه “وجه شيطان”. وسوف نلاحظ أن أحلامها انعكاس لعلاقتها العاطفية المحبطة،. ويتوازى مع هذه الأحلام ما يمكن أن نسميه بالحكايات “الكنائية” المعبرة عن حكاية الرواية، حين رأت مثلاً “فراشة بيضاء ميتة على الأرض، وبعدها بثانية واحدة وجدت أخرى تحاول الهرب إلى الخارج ولا تفلح، لكنها بعد عدة محاولات نجحت أخيراً في الإفلات وحلقت نحو البعيد”.
الراوي التقريبي
فحركة الفراشة الثانية ترمز إلى توق الساردة إلى الإفلات من أسرها، والأمر نفسه يحدث حين رأت نفسها داخل نفق مظلم ثم تتبين في آخره ضوءاً، وحين تقترب منه لا تبصر سوى بياض يعمي بصرها. وأحياناً يصبح تصوير المكان معبراً عن طبيعة العلاقات الإنسانية، وتقول “في منزلنا الجديد ذي المستويين، لا أحد في الطابق السفلي يعلم شيئاً عما يحدث في الطابق العلوي”.
والراوي التقريبي هو الذي يتوجه بخطابه مباشرة إلى المتلقي في غالب مشاهد الرواية، وهو ما يجعل السرد قريباً من الدراما البريختية “هذه الفقرة تحتاج إلى مزيد من السرد، بعد العبارة الأولى، وفي سياق التذكر من الممكن ربط فراغ المعدة والريق الجاف، بالأعراض الجسدية التي كانت تعانيها البطلة”. وبصورة عامة يقوم السرد على فنية التداعي الحر حيث الانتقال من حال لأخرى، وتوظيف تقنية المونولوغ الداخلي الذي يقترب من حدود المناجاة، وتعدد المروي عليه في بعض المواضع: الحبيب والأم خصوصاً، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة على طريقة آني إرنو التي تذكرها صراحة “فكل نوفيلا كتبتها كانت تمثل ملمحاً واحداً من حياتها، حتى أصبحت ملكة البازل والفسيفساء والتفاصيل الصغيرة”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية