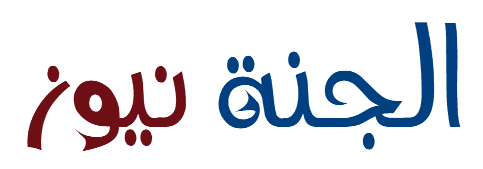صرحت نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة بأن ورشة العمل الوطنية للتصديق على إطار كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين (AI CFT) التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة؛ لإعداد المعلمين وتطويرهم ودعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، تستهدف مناقشة إطار عمل يضع المعلمين في صميم التحول الرقمي – ليس كمستخدمين للتكنولوجيا، بل كقادة ومبتكرين فاعلين في الاستخدام الأخلاقي والمتمحور حول استخدام الإنسان للذكاء الاصطناعي في التعليم.
وأضافت سانز أن منظمة اليونسكو تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل دائمًا متمحورًا حول الإنسانية، ولا ينبغي للتكنولوجيا أن تحل محل المعلمين أبدًا؛ بل يجب أن تُمكّنهم، كما ينبغي أن تُعزز القدرات البشرية، وتحمي حقوق الإنسان، وتشجع التعلم مدى الحياة للجميع.
وأعربت مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة عن تقديرها لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار الوطني لكفاءة الذكاء الاصطناعي للمعلمين (AI CFT) في مصر، والذي سيُرسي الأساس لإعداد المعلمين للتفاعل النقدي والإبداعي مع الذكاء الاصطناعي في التدريس داخل الفصول الدراسية.
وأشارت سانز أنه فى مصر، تُعد الشراكة الممتدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموذجًا يُحتذى للتعاون العملي، وتجسيدا للتعاون الذي يكون محركًا للابتكار الهادف.
وأوضحت بأنه في إطار مشروع «المدارس المفتوحة المُمكَّنة بالتكنولوجيا للجميع TEOSS»، عملنا سويًا على مواءمة الإطار المرجعي لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين، بما يضمن أن يعكس التحول الرقمي في التعليم أولويات مصر وواقعها الوطني، مشيرة إلى أنه تم تنظيم المسابقة الوطنية لتميز المعلمين في إعداد المحتوى الرقمي، التي أبرزت إبداع المعلمين المصريين وابتكارهم، والتى شارك فيها أكثر من 600 معلم قدّموا نماذج مميزة لتوظيف التكنولوجيا في إثراء العملية التعليمية.
وقالت إن تقرير الرصد العالمي للتعليم (GEM Report 2024 /2025)، أشار إلى ريادة مصر في مجال تدريب المعلمين والتحول الرقمي، وذُكرت مصر فيه عدة مرات كنموذج للتقدم، حيث تلقّى معظم معلمي المرحلة الابتدائية تدريبًا، وتلقى أكثر من 90٪ منهم تدريبًا في تقييمات القراءة.
كما أشادت بتواصل شراكة اليونسكو مع شركة هواوي من خلال مشروع المدارس المفتوحة المُمكَّنة بالتكنولوجيا دعم التعليم الرقمي عبر مراكز التعلم عن بُعد والدورات الرقمية وبرامج تدريب تكنولوجيا المعلومات للمعلمين في المناطق النائية.
وأضافت أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتعاون الوزاري القوي، اتخذت مصر خطوات ملموسة لإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم وبناء القدرات، بما يعكس رؤية مستقبلية تضع الإنسان والمعرفة والابتكار الأخلاقي في قلب التنمية.
وفي السياق، أكدت سانز التوافق الكامل للإطار مع الرؤية الوطنية للتعليم والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما يعكس طموح مصر في توظيف التكنولوجيا لتحقيق تعليم شامل وعالي الجودة للجميع.
وأشادت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التعليم، خصوصًا الجهود المبذولة لتحسين بيئات التعلم، وحل مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية والحد منها، والتي تعد من خطوات أساسية في تحسين جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية أكثر فعالية وإنصافًا، بالإضافة إلى ما تحقق على صعيد الحضور الطلابي، والذي بلغ نحو 87% في الفصول الدراسية، والذي يعكس التزامًا واضحًا وجادًا من الدولة المصرية تجاه النهوض بالعملية التعليمية.
المصدر : كشكول